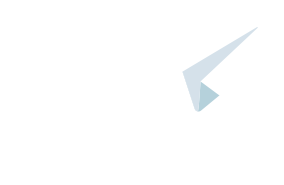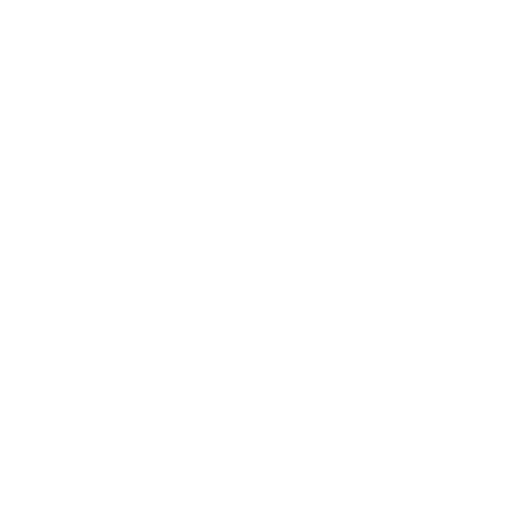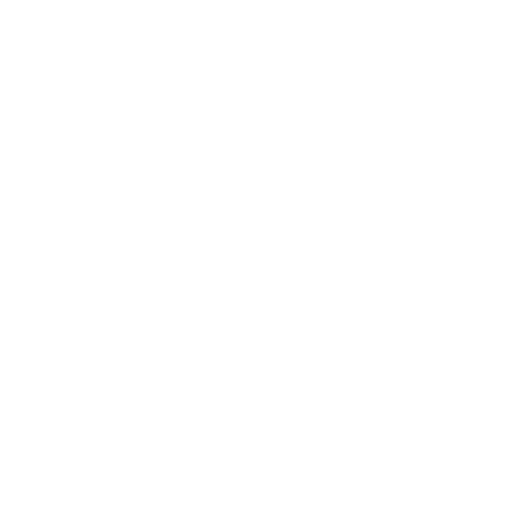المسائل الفقهية


العبادات


التقليد


الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها


التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به


الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض


الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس


الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة


الصلاة


مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)


افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)


الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)


الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم


الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف


الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*


الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر


الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه


الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين


زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة


ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة


احكام عامة


المعاملات


التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة


الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة


الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية


اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات


الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن


الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة


الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة


الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة


النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة


الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان


الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات


الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة


الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة


الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات


الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات


علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية


الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة


المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة


المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


الفقه المقارن


كتاب الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع


احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء


الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه


الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء


المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة


الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها


كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد


افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر


الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة


كتاب الزكاة

احكام الزكاة


ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة


زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم


كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم


كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر


اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس
أدلّة الاُصوليين على أصالة البراءة بالآيات
المؤلف:
ناصر مكارم الشيرازي
المصدر:
أنوَار الاُصُول
الجزء والصفحة:
ج 3 ص 19.
24-8-2016
2316
منها: قوله تعالى: {مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا } [الإسراء: 15].
حيث إنّه وردت فيها ثلاث فقرات:
أحدها: أنّ نتيجة عمل كلّ إنسان تعود إلى نفسه: (من اهتدى فإنّما يهتدي لنفسه ومن ضلّ فإنّما يضلّ عليها).
ثانيها: ما يكون بمنزلة المفهوم للحكم الأوّل، أي: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] وكلّ واحد من هذين الحكمين إرشاد إلى ما يحكم به العقل.
ثالثها: البراءة في موارد عدم البيان والبعث: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15] وهى تؤكّد بالآية التالية لها، أي قوله تعالى: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا} [الإسراء: 16] حيث إنّه بيّنت فيها كيفية العذاب المذكور في تلك الآية وأنّه يقع بعد الأمر ووقوع الفسق، كما أنّ المراد من بعث الرسل في تلك الآية إنّما هو إتمام الحجّة على الناس، فهو كناية عن بيان التكليف، فلا موضوعيّة للبعث كما يشهد عليه أنّه لا يعقل العذاب في صورة البعث مع عدم البيان.
ثمّ إنّ هيهنا آيتين اُخريين توافقان الآية المذكورة في الدلالة على البراءة في ما نحن فيه، وقد غفل عنهما في كلماتهم:
الاُولى: قوله تعالى: { وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ} [القصص: 59] حيث لا يخفى إنّ دلالة هذه الآية أظهر ممّا ذكره القوم، لما ورد فيها من التعبير بـ «يتلوا عليهم آياتنا» الذي يدلّ صريحاً على بيان التكليف وإنّه لا عقاب إلاّ بعد البيان، فلا حاجة فيها إلى التوجيه المذكور في تلك الآية من أنّ البعث كناية عن البيان.
الثانية: قوله تعالى: { وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى} [طه: 134] حيث إنّ المراد من كلمة «قبله» هو قبل بعث الرسل، فتدلّ على البراءة بناءً على أنّ نقل كلام الكفّار مشعر بالقبول.
وبالجملة، إنّ لهذه الآيات الثلاثة مدلولا واحداً مشتركاً، وهو البراءة في الشبهات الحكميّة مطلقاً.
المناقشة:
ولكنّه قد يناقش في دلالتها باُمور عديدة، وما قيل أو يمكن أن يقال فيها اُمور خمسة:
الأمر الأوّل: ما أورده المحقّق الخراساني(رحمه الله)، وحاصله: إنّ الآية تدلّ على نفي فعلية العذاب لا نفي استحقاقه، ونفي الفعليّة ليس لازماً مساوياً لنفي الاستحقاق حتّى يدلّ نفيها على نفيه، بل هو أعمّ من كونه من باب عدم الاستحقاق أو من باب تفضّله تبارك وتعالى على عباده مع استحقاقهم للعذاب، فلا يصحّ الاستدلال بالآية على البراءة.
ثمّ أورد على نفسه بأنّ المخالفين يعترفون بالملازمة بين نفي الفعليّة ونفي الاستحقاق.
وأجاب عنه أوّلا: بأنّ قبول الخصم لا يوجب صحّة الاستدلال بها إلاّ جدلا مع أنّنا نطلب الحجّة بيننا وبين الله تعالى سواء قبل الخصم أو لم يقبل.
وثانياً: بأنّ عدم وجود الملازمة بين الأمرين أمر واضح، ضرورة أنّ ما شكّ في وجوبه أو حرمته ليس عند الخصم بأعظم ممّا علم بحكمه، فإذا لم تكن ملازمة بينهما في المخالفة القطعيّة فعدمها في المخالفة الاحتماليّة بطريق أولى.
أقول: يمكن الجواب عنه بأنّ ما يهمّنا في الفقه إنّما هو الأمن من العذاب، وهو حاصل بنفي الفعليّة سواء لزمه نفي الاستحقاق أم لا.
الأمر الثاني والثالث: ما أفادهما الشيخ الأعظم(رحمه الله) من أنّ ظاهر الآية الإخبار بوقوع العذاب سابقاً بعد البعث فيختصّ بالعذاب الدنيوي الواقع في الاُمم السابقة، فمحصّل كلامه: أوّلا: أنّ الآية مختصّة بالاُمم السابقة، وثانياً: أنّ الله تعالى قد أخبر بنفي خصوص العذاب الدنيوي، وليس في الآية دلالة على أنّه تعالى لم يعذّبهم لعدم استحقاقهم له كي يكون دليلا على نفي العقاب قبل البيان مطلقاً، أي الدنيوي والاُخروي جميعاً بل لعلّه لم يفعل ذلك منّة منه تعالى في خصوص الدنيا.
والجواب عنهما واضح، أمّا بالنسبة إلى الأوّل منهما فلأنّ لحن الآية الشريفة إنّما هو لحن قوله تعالى: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] ، فيدلّ على أنّه لا يكون العذاب من دون بعث الرسول لائقاً بشأنه تعالى، ولا معنى لاختصاص هذا المفهوم بالأمم السابقة كما تشهد عليه الفقرتان السابقتان على هذه الفقرة (أي قوله تعالى { فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا} [يونس: 108] وقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] حيث إنّه لا إشكال في عدم اختصاصهما بالأمم السابقة.
وأمّا بالنسبة إلى الثاني منهما فلأنّه إذا لم يعذّبهم في الدنيا فعدم تعذيبه في الآخرة بطريق أولى، وهو عذاب يدوم بقاؤه ولا يخفّف عن أهله، والشاهد عليه الآية اللاحقة وهى قوله تعالى: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا } [الإسراء: 16]
الأمر الرابع: «إنّ أقصى ما تدلّ عليه الآية المباركة هو أنّ المؤاخذة والعقوبة لا تحسن إلاّ بعد بعث الرسل وإنزال الكتب وتبليغ الأحكام والتكاليف إلى العباد، وهذا لا ربط له بما نحن فيه من الشكّ في التكليف بعد البعث والإنزال والتبليغ وعروض اختفاء التكليف لبعض الموجبات التي لا دخل للشارع فيها»(1).
والجواب عنه: أنّ بعث الرسل في الآية كناية عن إتمام الحجّة كما مرّ، فتدلّ على نفي العذاب ما لم تتمّ الحجّة بعد البعث، والشاهد عليه قوله تعالى في الآية اللاحقة: (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ ...) فهى تدلّ على أنّ الميزان في العذاب هو صدور الأمر ووقوع الفسق بعده، كما يشهد عليه أيضاً ما مرّ من قوله تعالى في سورة القصص: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ...} [القصص: 59] لأنّها تصرّح بأنّ الملاك هو تلاوة الآيات لا مجرّد البعث.
الخامس: النقض بالمستقلاّت العقليّة، فإنّه لا إشكال (كما مرّ في بعض الأبحاث السابقة) في تعذيبه تعالى على ترك المستقلاّت العقليّة، كقبح قتل النفس المحترمة والسرقة والخيانة وغيرها من المعاصي التي يحكم بقبحها العقل مستقلا، ولو وقعت قبل بعث الرسل.
والجواب عنه: أنّ الآية منصرفة إلى أحكام تحتاج إلى البيان، ولا حاجة إلى البيان في المستقلاّت العقليّة التي لا يصحّ فيها الإعتذار بقولهم {لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى } [طه: 134] ، ولذلك يقال في مباحث العقائد أنّ من فوائد وجود النبي (صلى الله عليه وآله)تأكيده المستقلاّت العقليّة والتأسيس بالنسبة إلى غيرها.
فتلخّص ممّا ذكر أنّ جميع الإشكالات الواردة مندفعة، وإنّ الآية صالحة للاستدلال على أصالة البراءة في الشبهات الحكميّة التحريميّة.
نعم إنّ النسبة بين هذه الآية والأخبار التي استدلّ بها الأخباريون على الاحتياط هى نسبة الورود، فهي مورودة بتلك الأخبار لأنّ لسانها لسان قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو بلا حجّة، وتلك الأخبار على فرض دلالتها بيان وحجّة، لكن تظهر ثمرتها في تأسيس الأصل الأولي في المسألة وأنّ الأصل هو البراءة، فيرجع إليها إذا ناقشنا في دلالة تلك الأخبار على الاحتياط.
ومنها: قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا } [الطلاق: 7] ، وتقريب الاستدلال بها أنّ «ما آتاها» بمعنى «ما أعلمها» أي لا يكلّف الله نفساً إلاّ ما آتاها من العلم، فدلالتها على البراءة واضحة.
وقد يناقش في الاستدلال بها بأنّ المراد من الموصول فيها إنّما هو المال بقرينة ما ورد في صدرها من قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 6، 7] فيكون المعنى حينئذ: لا يكلّف الله نفساً إلاّ مالا آتاها، أي أعطاها، وهو أجنبي عن البراءة كما هو واضح.
ولكن في اُصول الكافي عن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): أصلحك الله هل جعل في الناس أداة ينالون بها المعرفة؟ قال: فقال «لا»، قلت: فهل كلّفوا المعرفة؟ قال «لا، على الله البيان، لا يكلّف الله نفساً إلاّ وسعها، ولا يكلّف الله نفساً إلاّ ما آتاها»، قال: وسألته عن قوله: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة: 115] قال: «حتّى يعرّفهم ما يرضيه وما يسخطه»(2).
فهذه الرواية تؤكّد أنّ الآية ناظرة إلى العلم والمعرفة، ولا يخفى أنّ المراد من المعرفة فيها ليست معرفة أصل وجود الله تبارك وتعالى، لأنّه لا ريب في أنّ أحسن الأدلّة على وجوده تعالى وأوّلها هو العقل من دون اعتماد عى البيان، فليكن المراد معرفة الصفات التي لا تصاب بالعقول، ولذا اشتهر بين العلماء أنّ أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية.
فلابدّ حينئذ من الجمع بين مورد الآية وهذه الرواية، فنقول: يحتمل في المراد من الموصول في الآية ثلاثة وجوه:
أحدها: أن يكون المراد المال.
ثانيها: أن يكون المراد المعارف والتكاليف.
ثالثها: الجامع بين المعنيين، فاستعمل الموصول في مطلق الاعطاء أعمّ من الاعطاء المالي واعطاء الحجّة والعلم.
فقد يقال: إنّ الموصول استعمل في المعنى الثالث، فيكون كلّ واحد من الموردين (مورد الآية ومورد الرواية) من مصاديق هذا المعنى الجامع فتكون دلالته على المراد تامّة.
لكن أورد عليه أوّلا: بأنّ «إرادة الأعمّ منه (من الإعلام بالحكم والتكليف) ومن المورد (مورد الآية) يستلزم استعمال الموصول في معنيين، إذ لا جامع بين تعلّق التكليف بنفس الحكم وبالفعل المحكوم عليه»(3).
وإن شئت قلت: «المفعول المطلق هو المصدر أو ما في معناه المأخوذ من نفس الفعل، والمفعول به ما يقع عليه الفعل المباين معه ولا جامع بين الأمرين حتّى يصحّ الإسناد»(4).
والجواب عنه: أنّ الموصول في الآية يكون مفعولا به في كلتا الصورتين، أي سواء اُريد منه نفس التكليف أو اُريد منه الأمر الخارجي الذي يقع عليه التكليف، لأنّ المراد من التكليف في الصورة الاُولى معناه اسم المصدري، أي ما كلّف به (لا المعنى المصدري)، فيكون المعنى: «لا يكلّف الله نفساً بتكليف كمعرفة صفات الله أو الإمام أو الأحكام كما ورد في سؤال الراوي في الرواية: «هل كلّف الناس بالمعرفة».
فعلى أي تقدير يكون الموصول مفعولا به ويصير المعنى: «لا يكلّف الله نفساً إلاّ تكليفاً أو مالا آتاها» فاستعمل الموصول في القدر الجامع بينهما، وهو مطلق المعطى أعمّ من الاُمور المادّية كالمال أو المعنوية كالمعرفة، ويكون هذا الجامع هو المفعول به، كما أفاده المحقّق النائيني(رحمه الله) بما نصّه: «لكن الإنصاف أنّه يمكن أن يراد من الموصول الأعمّ من التكليف وموضوعه، وإيتاء كلّ شيء إنّما يكون بحسبه، فإنّ إيتاء التكليف إنّما يكون بالوصول والإعلام، وإيتاء المال إنّما يكون بإعطاء الله تعالى وتمليكه، وإيتاء الشيء فعلا أو تركاً إنّما يكون بإقدار الله تعالى عليه فإنّ للإيتاء معنىً ينطبق على الاعطاء وعلى الاقدار، ولا يلزم أن يكون المراد من الموصول الأعمّ من المفعول به والمفعول المطلق، بل يراد منه خصوص المفعول به»(5).
وثانياً: بما مرّ في آية البعث من المحقّق النائيني(رحمه الله) أيضاً من أنّ أقصى ما تدلّ عليه الآية هو أنّ المؤاخذة والعقوبة لا تحسن إلاّ بعد تبليغ الأحكام والتكاليف إلى العباد، وهذا لا ربط له بما نحن فيه من الشكّ في التكليف بعد التبليغ وعروض اختفاء التكليف ببعض الموجبات التي لا دخل للشارع فيها.
والجواب عنه: هو الجواب من أنّ المراد من الإيتاء هو إتمام الحجّة، فتدلّ الآية على نفي العذاب ما لم تتمّ الحجّة بعد التبليغ، وهو المطلوب.
وثالثاً: بأنّ المقصود في الآية وكذلك في الرواية التكليف بما لا يطاق، فإنّ معرفة صفاته تعالى مثلا خارجة عن طاقة البشر، ولا يمكن حصولها له إلاّ من ناحية البيان، فالآية تنفي التكليف بما لا يطاق لا التكليف بالاحتياط في مثل التدخين الذي يكون ممكناً للإنسان، وليس خارجاً عن طاقته، والشاهد على ذلك أنّ الإمام(عليه السلام) ذكر هذه الآية في جنب قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] التي لا إشكال في أنّ المقصود منها التكليف بما لا يطاق، فالآية حينئذ أجنبية عمّا نحن فيه.
ورابعاً: بأنّ سند الرواية ضعيف من ناحية عبد الأعلى المجهول في كتب الرجال، اللهمّ إلاّ أن يقال: بأنّه وقع بعد حمّاد وهو من أصحاب الإجماع، ولكن المختار عندنا عدم تماميّة هذه القاعدة.
وبهذا يظهر أنّ الآية غير صالحة للاستدلال بها في المقام.
ومنها: قوله تعالى: { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [التوبة: 115] ودلالتها على المدّعى تتمّ إذا كانت «يضلّ» بمعنى «يعذّب» لأنّ مفادها حينئذ عدم العقاب بلا بيان، فالمهمّ في المقام تعيين معنى «يضلّ» بعد عدم تصوّر معناها اللغوي المعروف بالنسبة إلى الباري تعالى، فنقول: يحتمل فيها أربعة وجوه:
1 ـ أن يكون بمعنى التعذيب كما مرّ آنفاً.
2 ـ أن يكون بمعنى الحكم بالضلال.
3 ـ أن يكون بمعنى الخذلان أي ترك العون والإمداد وسلب التوفيق.
4 ـ أن يكون بمعناه الحقيقي مع حقيقة الإسناد بالنسبة إليه تعالى من باب إنّه مسبّب الأسباب وسبب في تأثير عمل العبد في ضلالته، فهو الذي جعل العمل السيئ والذنوب الكبار سبباً للضلالة عن طريق الحقّ، فيصحّ إسناده إليه تعالى حقيقة كما يصحّ إسناده كذلك إلى الفاعل بلا واسطة، وهذا نظير من قتل نفسه بشرب السمّ حيث يصحّ إسناد القتل إليه حقيقة لأنّه شرب السمّ باختياره، وإلى الباري تعالى كذلك لأنّه خلق السمّ بحيث يوجب القتل.
ولا يخفى أنّ الإسناد في الوجوه الثلاثة الاُول مجازاً، فلا وجه للذهاب إليها مع إمكان حفظ الكلمة على معناه الحقيقي بالوجه الأخير، كما أنّه كذلك في الآيات المشابهة التي استند الاضلال فيها إلى الله تعالى.
منها: قوله تعالى: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ} [إبراهيم: 27]
ومنها: قوله تعالى: {كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ } [غافر: 34] فاستناد الاضلال إليه تعالى أمر مأنوس في القرآن الكريم، ولا ريب في عدم مجازيته، لأنّ كلّ فعل يصدر من العباد يصحّ إسناده إليه تعالى حقيقة «لأنّه المالك لما ملّكك والقادر على ما عليه أقدرك» كما ورد في حديث الإحتجاج(6).
وبالجملة الآية تدلّ على عدم اضلال الله تعالى للعباد حتّى يبيّن لهم الحلال والحرام لقوله تعالى فيها: {حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة: 115] وبما أنّ الاضلال منشأ للعذاب بل هو نوع من العذاب الإلهي فدلالة الآية على عدم العذاب من دون البيان تكون بالأولوية أو بإلغاء الخصوصيّة.
وممّا ذكرنا يظهر الجواب عمّا أورده بعض على دلالة الآية من أنّها تدلّ على نفي العذاب الدنيوي لا الاُخروي، وذلك لأنّ دلالتها على نفي العذاب الاُخروي ـ وهو عذاب تطول مدّته ويدوم بقاؤه ـ بطريق أولى كما مرّ ذلك بالنسبة إلى آية البعث.
بقي هنا شيء:
وهو أنّ جميع هذه الآيات إنّما تأسّس لنا الأصل الأوّلي وتدلّ على عدم العذاب بلا بيان، وحينئذ تكون أدلّة الأخباري على فرض تماميتها واردة عليها، لأنّها حينئذ تكون بمنزلة البيان، لكن سيأتي عدم تماميتها فالمرجع هو ما يستفاد من هذه الآيات.
هذا كلّه في الآيات التي استدلّ بها على البراءة.
______________
1. فوائد الاُصول: ج 3، ص 333.
2. اُصول الكافي: ج 1، باب «البيان والتعريف ولزوم الحجّة» من كتاب الحجّة.
3. أورده الشيخ الأعظم(رحمه الله) في رسائله.
4. تهذيب الاُصول: ج 2، ص 143، طبع جماعة المدرّسين.
5. فوائد الاُصول: ج 3، ص 332، طبع جماعة المدرّسين.
6. راجع تفسير الميزان: ج 1، ص 101.
 الاكثر قراءة في البراءة
الاكثر قراءة في البراءة
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












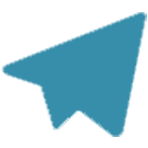
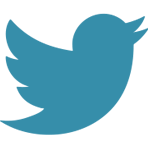

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)