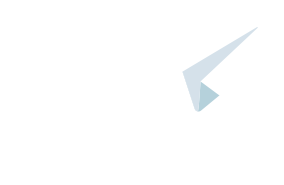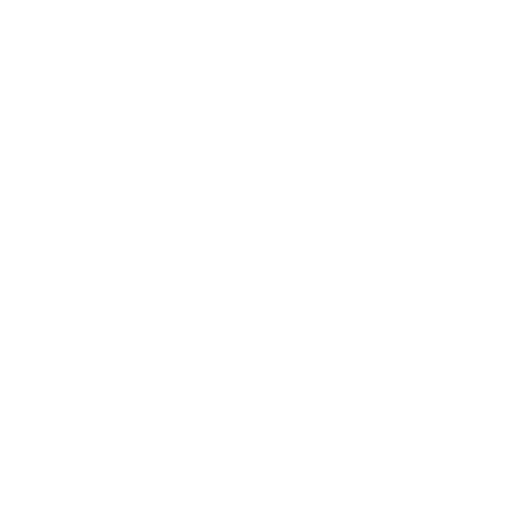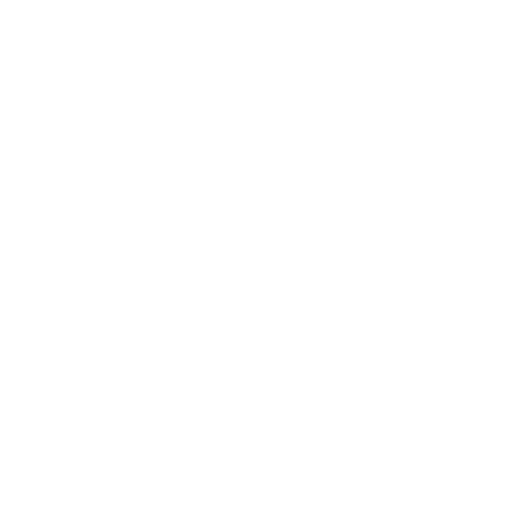الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة و الغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع و التقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق و الكمال

السلام

العدل و المساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة


الآداب

اداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم و الزكاة و الصدقة

آداب الحج و العمرة و الزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

الحقوق


الرذائل وعلاجاتها

الجهل و الذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة و النميمة والبهتان والسباب

الغضب و الحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

الكذب و الرياء واللسان

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي و الغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة


علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أدعية وأذكار

صلوات وزيارات

قصص أخلاقية

إضاءات أخلاقية

أخلاقيات عامة
الأنانية في أبعادها الدينيّة والاجتماعيّة.
المؤلف:
الشيخ علي حيدر المؤيّد.
المصدر:
الموعظة الحسنة
الجزء والصفحة:
ص 427 ـ 443.
2023-03-12
5500
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): «يا علي ما كرهته لنفسك فاكرهه لغيرك وما أحببته لنفسك فأحببه لأخيك» (1).
الأخلاق الفاضلة معراج الإنسان:
الصفات الأخلاقيّة الحميدة تسكن في قلب كلّ إنسان طلبها، وجاهد شهواته وميوله ورغباته حتّى تصير ملكات في نفسه يتّصف بها وتظهر آثارها على السلوك الإنساني.
وهي تعرف من خلال آثارها الحسنة والله عزّ وجلّ جعل في الإنسان قوة لقبول تلك الصفات واستعدادات لطلبها والتحلّي بها، وطرقاً للحصول عليها لأنّ الإنسان إنّما تظهر حقيقته الواقعيّة الإنسانيّة بهذه الصفات لأنّها الفارق والشاخص بين الإنسان العالم والجاهل، وبين الإنسان في مراحل كماله العليا والإنسان المتسافل الذي لا يبرح عن الالتصاق بالأرض، والأخلاق الفاضلة تجعل الإنسان يعرج ويتسامى ويرتفع مع الروح فيعيش الافاق الرحبة لذلك نرى الإنسان الخلوق لديه سعة في صدره بحيث يستوعب الناس بأخلاقه؛ لأنّه يرى حقيقته الإنسانيّة في أصل وجودها فقيرة من كلّ جهاتها فلا يبقى مجال لأنّ يترك الناس ويبتعد عنهم أو يتكبّر عليهم بل إنّه يحتك بهم لأجل التكامل لاسيّما مع العلماء والمفكّرين وأهل الخير والصلاح ومن جهة أخرى يرى في داخله اندفاعاً ذاتيّاً من قبل الملكات الصالحة تدفعه إلى فعل الخير للآخرين وإيصال برّه إلى بقيّة الناس.
ومن الواضح أنّه كلما انتشرت هذه الصفات بين أفراد المجتمع امتاز ذلك المجتمع بأمرين:
1 - ارتباطه الوثيق بالله عزّ وجلّ لأنّ الله هو المثل الأعلى للمجتمعات المتديّنة، ووجود مقدّس كامل خالٍ من كلّ عيب ونقص يتّصف بصفات غير متناهية من قبيل الرحمة والرأفة والرازقيّة، فيعمل الإنسان جاهداً من أجل أن يتحلّى بهذه الصفات الحميدة بالقدر المستطاع ومهما سعى الإنسان في هذا الطريق إلّا أنّ صفاته ستكون متناهية بالنتيجة.
ومن أجل ذلك كان الإنسان في حركة دائمة نحو مثله الأعلى يسأله الفيض والكمال والتوفيق والنجاة. قال تعالى: {وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الروم: 27].
2 - خلو المجتمع - في الجملة - من مظاهر الرذيلة والفساد والانحراف والأمراض النفسيّة من قبيل الكبر والحرص والظلم؛ لأنّه عندما تشاع الصفات الحميدة في نفوس الأفراد ينعكس أثر ذلك على سلوكهم العام في علاقاتهم وتعاملهم مع الحياة.
ومن أجل ذلك كانت الأخلاق من المبادئ الرئيسية في الإسلام فنراه (صلى الله عليه وآله) يفتتح رسالته الشريفة بقوله: «بُعثت لأتمّم مكارم الأخلاق» (2).
لأنّ في تمامية مكارم الأخلاق استقامة الإنسان وفي استقامته نجاته وهذا هو هدف الدين في مختلف الحقب الزمانيّة.
فكان الأنبياء (عليهم السلام) يجسّدون الصفات عمليّاً في سلوكهم وعملهم اليوميّ لكي يعلموا الإنسان الأخلاق. ولا شكّ أنّ أبرزهم وأفضلهم هو رسولنا العظيم (صلى الله عليه وآله) حتى أطلقت عليه الناس قبل البعثة لقب (الصادق الأمين). ووصف خلقه القرآن الكريم بالعظمة بقوله عزّ وجلّ: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4]
صورتان متقابلتان:
إنّ لبعض الناس نفوساً منشرحة منفتحة في تفكيرها وفي إحساسها تعبّر حدودها لتصل إلى الآخرين وتعيش آلامهم ومعاناتهم وأفراحهم.
فهؤلاء الأشخاص قد خرجوا من تقوقع الذات وانطوائها على نفسها إلى الفضاء الاجتماعي الرحب ليكونوا معيناً للناس وقد أكّد أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام) هذا المعنى وغرسوه في النفوس كثيراً فقالوا:
«خير الناس من انتفع به الناس» (3).
و «مَن أصبح لا يهتمّ بأمور المسلمين فليس منهم..» (4).
كذلك الروايات التي تشيد بمحبّة النّاس ومواساتهم وإيثارهم أو تشيد بدفع الصدقة وإقراض المؤمن أو الإنفاق أو مطلق العمل الصالح الذي ينتفع منه الآخرون.
كلّ ذلك دلالة على الدعوة للعيش بآفاق واسعة تشمل الآخرين وقد جعل الإسلام طرقاً لذلك أبرزها مثلاً صلاة الجماعة والحجّ وعيادة المريض وتشييع الجنازة وغيرها، وكلّها تدعو الإنسان لأن يتّصل بالناس فيتفاعل معهم فينفعهم أو ينفعونه.
وهناك نوع آخر من الناس وهم الذين لا يعيشون إلّا في آفاقهم الذاتيّة ولا يفكرون إلّا في نفوسهم ومصالحهم، أي أنّه لا يخرج في تفكيره وسلوكه عن حدود ذاته ومنافعه بل يتمحور دائماً حول ذاته فلا هو ينفع الناس ولا الناس ينفعونه لأنّه لا يحتك بهم ولا يعلمون ما يريده فيقدّمونه له، وإلى ذلك دعى الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) في وصيّته لمولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) تعليماً لنا لأنّ نتفتح وأن نشرح صدورنا لكي نعيش مع الآخرين آلامهم وأفراحهم «ما كرهته لنفسك فاكرهه لغيرك» (5).
وقال الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): «أنصف الناس من نفسك وأهلك وخاصّتك ومَن لك فيه هوى واعدل في العدو والصديق» (6).
وقال (عليه السلام) أيضاً:
«الإنصاف من النفس كالعدل في الإمرة» (7).
حب الذات غريزة نفسيّة:
توجد في أعماق كلّ إنسان مجموعة من الدوافع والغرائز الفطريّة تنشأ مع تكوّنه وتبرز وتظهر آثارها كلّما ترعرع وتفاعل الإنسان مع بيئته.
والغريزة لغويّاً اسم مشتق من غرز ومثاله: غرز الشجرة في الأرض أو غرز المسمار في الباب.
وأمّا اصطلاحاً فهي القوة الكامنة في الكائن الحي تدفعه إلى أنواع مختلفة من السلوك بل هي المحرّك الأول لكلّ سلوك باتفاق جميع علماء النفس (8).
إذن هي القوة الراسخة في النفس والمتلاحمة معها بقوة بحيث لا يمكن أن نتصور إنساناً بدون غرائز. ومثالها غريزة الطعام والجنس والنوم وحب الاستطلاع وغريزة حب الذات التي هي مدار البحث.
إنّ حب الذات غريزة متجذّرة في نفس الإنسان لا يمكن إنكارها أو التنكّر لها، وهي كباقي الغرائز الفطريّة تعبّر عن حاجات معيّنة للإنسان وتقوم بدور إيجابيّ في حياته فالباري عزّ وجلّ خلق كلّ غريزة وقوّة في الإنسان لهدف معين تؤدّيه، لكنّنا كثيراً ما نلاحظ انحرافات في مسار الإنسان ليس منشأها الغرائز بل الإرادة التي تحدّد مسار الغرائز والعقل الذي لديه قدرة على التحكّم بها.
فقد يستخدم الإنسان هذه القدرة ويسخّرها لإشباع رغباته عن طريق هذه الغريزة بشكل سيّئ ممّا يضرّ بنفسه ومجتمعه، فيستعمر الآخرين ويستثمر جهودهم ويعتدي على ممتلكاتهم وحقوقهم. فإطلاق العنان لهذه الغريزة في غاية الخطورة، لما يترتّب عليه من إفرازات سلبيّة تفتك بالمرء ومجتمعه ومن أبرز مظاهرها الأنانية التي تصيب الإنسان نتيجة إطلاق العنان لغريزة حب الذات.
أو نستطيع أن نسمّيه عبادة الهوى والذات الذي يسبّب الكثير من الأمراض السيئة كالتعصّب والتكبّر والرياء والغرور، ولهذا المرض درجات أو مراتب قد تتفاوت في الشدة والضعف من شخصيّ إلى آخر وهنا تكمن أهميّة معالجة هذا المرض الخطير على الإنسان وعلى المجتمع.
مثلٌ سامٍ في الإيثار:
يُحكى أنّ رجلاً يُضرب به المثل في الجود والكرم والإيثار وهو «كعب بن مامة بن عمر بن ثعلبة الأيادي» خرج مع قافلة تريد إحدى المدن البعيدة عن بلدهم وكان ذلك في حرّ الصيف فضلّوا الطريق فلقيهم في أثناء الطريق رجل من بني النمر بن قاسط فصحبهم، فشحّ ماؤهم فكانوا يقتسمون الماء بينهم بحصص معيّنة وذلك أن يطرح في القدح حصاة ثم يصبّ فيه من الماء بقدر ما يغمر الحصاة فيشرب كلّ واحد منهم قدر ما يشرب الآخر.
ولمّا نزلوا للشرب ودار القدح بينهم حتّى انتهى إلى كعب، رأى أنّ الذي صحبهم أثناء الطريق قد أخذ يحدّ النظر إليه، فآثره على نفسه وقال للساقي: اسقِ أخاك النمري. فشرب نصيب كعب من الماء ذلك اليوم! ثم نزلوا من الغد منزلهم الآخر فاقتسموا ماءهم كما فعلوا بالمرّات الأولى، فنظر إليه النمري كنظرة أمس، وقال كعب كقوله بالأمس اسقِ أخاك النمريّ، ثم ارتحل القوم وأمّا كعب فقد وقع إلى الأرض من شدّة العطش والضعف، فالتفت إليه أقرانه وقالوا: يا كعب، ارتحل فلم يكن له قوة للنهوض، وكانوا قد قربوا من الماء فقالوا له: ردّ يا كعب، إنّك وارد، فعجز عن الجواب. ولمّا أيسوا منه خيّموا عليه بثوب يمنعه من السبع أن يأكله وتركوه مكانه وذهبوا إلى الماء وشربوا وارتووا ثم أخذوا الماء إلى كعب فلمّا وصلوا إليه وجدوه ميّتاً (9).
وهكذا ضرب بفعله هذا، المثل الأعلى للإيثار على النفس وحبّ الغير كحبّه لنفسه وأكثر، كمالاً للإيمان الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن بالنسبة للآخرين من المؤمنين.
مراتب الأنانية:
للأنانية ثلاث مراتب:
ـ المرتبة الأولى: التمحور حول الذات.
إنّ التمحور حول الذات يعني أمرين، الأول أن ينهمك الإنسان في تحصيل لذّاته فحسب فيسخّر كلّ طاقاته وإمكاناته لأجل ذلك ويرفض أن يعطي ولو جزءاً بسيطا من هذه الطاقات والإمكانات لخدمة الآخرين من أبناء المجتمع، فيعيش في دائرة مغلقة (دائرة الأنا) يعمل ليعيش ويعيش ليعمل فقط فيصدق عليه قول أمير المؤمنين (عليه السلام):
«كالبهيمة المربوطة همّها علفها أو المرسلة شغلها تقمّمها تكترش من أعلافها وتلهو عمّا يُراد بها» (10).
والثاني: تحوّل ذات الإنسان الأنانية إلى قيمة عليا يقيس بها كلّ شيء وينظر من خلالها إلى كلّ شيء على خلاف الإنسان السويّ حينما تعرض عليه فكرة يعرضها على العقل والمبدأ لاكتشاف صحّتها أو خطئها.
أمّا الإنسان الأنانيّ فإنّه يخضع الأفكار والرؤى التي تعرض عليه إلى مقاييس المصلحة الشخصيّة والربح والخسارة وهو مستعد لأن يدوس كلّ القيم تحت قدميه إذا تعارضت مع مصالحه الشخصيّة.
والأمر الخطير في تقديس الذات هو تحوّل الذات إلى إله يُعبد كما في
الآية الكريمة: {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا} [الفرقان: 43].
أو ما جاء في قول الشاعر:
جربت ألف عبادة وعبادة *** فرأيت أفضلها عبادة ذاتي
فهكذا تصبح الشهوات والهوى إلهاً مقدّساً لديه مفترض الطاعة فالحق ما وافق هواه والباطل ما خالفه، ويعزو الله سبحانه وتعالى سبب مخالفة الكثير من المشركين للأنبياء ورفضهم للرسالات الإلهيّة إلى هذا المرض كما في قوله تعالى: {أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ} [البقرة: 87]
ـ المرتبة الثانية: ظهور الأخلاق والصفات الأنانية.
إنّ الأنانية مرض عضال يتفاقم ويزداد في شخصيّة الإنسان الأناني ويفرز صفات سلبيّة كما ذكرنا آنفاً ومن أهم هذه الصفات:
1- التعصّب: فالإنسان الأنانيّ الذي يتمحور حول ذاته يُصاب تلقائياً بمرض التعصّب للرأي أو الجماعة مهما كان هذا الرأي خاطئاً أو كانت جماعته تسير على الخطأ وهذا ما نلمسه في أفراد يعيشون في مجتمعنا لا يتنازلون عن آرائهم الخاطئة ويعتبرونها هي الصحيحة والمفيدة وما عداها باطلا.
وهؤلاء الأشخاص ينطبق عليهم المثل العربي القائل: «عنزة ولو طارت» وهو مثل يطلق على الإنسان المتعصّب وقصة هذا المثل هو أنّ اثنين من الأعراب كانا يمشيان في الصحراء فبدا لهما جسم أسود على مسافة بعيدة عنهما فقال أحدهما: هذا طائر كبير، وقال الثاني: لا إنّه عنز، فانتظرا لكي يقترب الجسم ويعرفا حقيقته وبعد لحظات اقترب منهما قليلا ثم بدأ يطير في الهواء بجناحيه، فالتفت الأول وقال: ألم أقل لك إنّه طير كبير، فقال صاحبه مصرّاً إنّه عنز، فقال له: ألا تراه يطير في الجو بجناحيه فقال: أبداً والله «عنزة ولو طارت».
وهذه الحالة تؤدّي إلى الشرك أحياناً حيث يقول الإمام الصادق (عليه السلام) عندما سُئل عن أدنى ما يكون الإنسان به مشركاً، قال: «مَن ابتدع رأياً فأحبّ عليه أو أبغض عليه» (11).
وتوجب دخول النار كما في قول الإمام الصادق (عليه السلام) أيضاً: «مَن تعصّب، عصبه الله بعصابة من نار» (12).
والعصبيّة بهذه الصورة هي صفة من صفات الجاهليّة المعروفة وذلك بنصّ القرآن الحكيم الذي عبّر عنها ب «الحميّة» وذلك في قوله تعالى: {إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [الفتح: 26].
وهي صفة مرفوضة في الإسلام بل عمل على رفعها من نفوس الناس وجعل محلّها المقياس الصحيح لهذه الحالة بأن يتعصّب المرء لمكارم الأخلاق والصفات الحميدة ومحاسن الأمور فقد قال الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبته المعروفة بالقاصعة:
".. فليكن تعصّبكم لمكارم الخصال، ومحامد الأفعال، ومحاسن الأمور، التي تفاعلت فيها المجداء والنجداء.." (13).
ويجعل الإيمان والتقوى أساساً في نفسه وقد جاء في خطبة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) يوم فتح مكة المكرّمة: «.. إنّ الله تبارك وتعالى قد أذهب عنكم بالإسلام نخوة الجاهليّة.. ألا وإنّ خيركم عند الله وأكرمكم عليه اليوم أتقاكم وأطوعكم له» (14).
2 - التكبّر: ومعناه رؤية الإنسان نفسه أفضل وأعلى من الآخرين بسبب النظرة التي ينظرها الأنانيّ لنفسه وصفة التكبّر من الصفات المذمومة بشدة في القرآن الكريم يقول عزّ وجلّ: {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ} [الزمر: 60].
وقوله عزّ وجلّ: {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ} [الأعراف: 146].
ويقول الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) حول هذه الصفة المذمومة: «إيّاك والكبر فإنّه أعظم الذنوب وألأم العيوب وهو حلية إبليس» (15) ويقول الإمام الباقر (عليه السلام): «ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخله من ذلك، قلّ ذلك أو كثر» (16).
وصفة التكبّر هي ذاتها التي كانت السبب في إخراج إبليس من الجنّة بقوله: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا} [الإسراء: 61] وفي آية أخرى: {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} [الأعراف: 12].
وإبليس كان عالماً لكنّه سقط في المعصية في لحظة تكبّر حيث ورد في الحديث الشريف عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لن يدخل الجنّة عبد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر"(17).
وهناك صفتان أخريان أيضاً هما الرياء والغرور، ناشئتان من الأنانية وحب الذات لا مجال لتفصيلهما.
ـ المرتبة الثالثة: معاداة الآخرين والعمل ضدهم.
إنّ مرض الأنانية في مراحله الأولى يكون الشخص الأناني فيها مهتماً بمصالحه فقط ولا يهتم بمصالح المجتمع، ومن ثم يبدأ ظهور الصفات الأنانية كالتعصب والتكبر وحب الظهور والغرور ومن ثم ينتقل من هذا النطاق الضيق إلى نطاق أوسع منه فيتصور أن الآخرين هم السبب في منعه من الوصول إلى ملذّاته وسعادته، ويرى إشباع رغباته وبروزه لا يكون إلاّ عن طريق سحق الآخرين ويبني لنفسه وجوداً قائماً على أنقاض الآخرين فيبدأ المسير في الحياة كالبلدوزر تجرف وتسحق كلّ مَن يقف في طريقها وذلك بتضخيم سلبيّات الآخرين الذين هم أعلى منه مقدرة وعلماً ومنزلة ويعتبر هذه السلبيّة أو تلك نقصاً وضعفاً في شخصيّة المقابل ويبرز هو كشخص عظيم وذا مكانة في المجتمع يفتّش عن سلبيّات الآخرين الأقدر منه عملاً وتفكّراً ويكون من الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا كما في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النور: 19].
ولا يلتفت إلى عيوبه حيث يقول رسول الله (صلى الله عليه وآله):
«لا تتّبعوا عورات المؤمنين فإنّه مَن تتبّع عورات المؤمنين تتبّع الله عورته، ومَن تتبّع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته» (18).
فلا يجني من فعله هذا سوى التعب والفشل بل أكثر من ذلك الفضيحة بين الناس التي وعده الله بها.
ويحسد الآخرين ويتمنّى زوال النعم عنهم وسقوطهم من مكانتهم الرفيعة حيث يقول أمير المؤمنين (عليه السلام): «الحاسد لا يشفيه إلّا زوال النعمة» (19).
وهذا النوع من الأمراض يؤثّر في نفس حامله أكثر ممّا يؤثّر في المقابل حيث يقول الإمام الصادق (عليه السلام): "إنّ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب" (20).
ومن الواضح أنّ هذا المرض غير حالة الغبطة وهي تمنّي ما هو موجود عند الغير دون تمنّي زوالها عنه فهي مباحة ومحمودة في الشريعة الإسلاميّة لما لها من آثار إيجابية على الإنسان والمجتمع.
وقفة مع أناني حسود:
ينقل التأريخ أنّ الحجّاج استدعى رجلين أحدهما أنانيّ حسود والآخر بخيل وقال لهما:
ليطلب كل منكما طلبه فإنّي أعطيه ما طلب واعطي صاحبه ضعف طلبته فلو أنّ أحدكم طلب (1000) دينار أعطي صاحبه (2000) دينار، فليبدأ أحدكما بالطلب فدبّ التردّد في نفسيهما إلى أن تقدّم الأنانيّ وقال: أن تفقأ عيني اليسرى، فقال الحجاج لماذا؟ فردّ الأناني الحسود لكي تعطي صاحبي ضعف ما تعطيني فتفقأ عينيه.
فقال الحجّاج: ما رأيت طلبة إلّا هذه الطلبة، لماذا لم تطلب مالاً أو منصباً حتّى تستفيد منه، فقال الأنانيّ: والله أنّ تفقأ عيني أهون عليّ من أن أرى صاحبي يأخذ ضعفين وأنا آخذ نصف ما أخذ.
والأنانيّ في هذه المرتبة يضع العراقيل في طريق الآخرين ليمنع تقدّمهم بعد أن يفشل في تضخيم السلبيّات للنيل منهم، وهذا ما له صور وأشكال متعددة.
يقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في هذا الخصوص: «ما عهد إليّ جبرائيل (عليه السلام) في شيء ما عهد إليّ في معاداة الرجال» (21).
وتزداد هذه الحالة خطورة حينما تنتشر في أوساط ينبغي لها أن تثبت حكم الإسلام حيث إنّ الأنانيّ يريد أن يحتكر العمل فقط له ولا نصيب للآخرين لذلك يدخل معهم في صراعات من شأنها إضعاف جبهتهم أمام جبهة الباطل.
الأنانية في منظار الدين:
إنّ حالة الأنانية لها مساوئ تعود على نفس حاملها وعلى المجتمع الذي يعيش فيه حيث إنّ الأنانيّين لا يفكّرون إلّا في أنفسهم ويتناسون الآخرين والهدف الذي خلقوا لأجله في هذه الدنيا، فهم يظلمون أنفسهم ويظلمون مجتمعهم بتعدّيهم على حقوق الآخرين والتشهير بهم، كذلك يعرقلون سير المجتمع بآرائهم الفاسدة التي تكون مبنيّة على أساس المصالح ممّا يؤدّي إلى إحداث ثغرات فيه وهذا ظلم لأفراد المجتمع.
كما تقتصر نظرتهم هذه على الحياة الفانية وينسون الحياة الخالدة التي تنتظرهم وما قدّموا من عمل في هذه الدنيا، فإنّ النظرة إلى العيش في هذه الدنيا فقط تجعل الإنسان يعمل ويخزّن الأموال دون أن يفكّر في إعطاء الحقوق الشرعيّة التي فرضت على بني البشر من خمس وزكاة، وهذه بدورها لها تأثير كبير على المجتمع الإسلاميّ وقوّته.
كذلك تجعله يتخلى عن الجانب الآخر من حياته وهي الحياة المعنوية التي هي جزء من كيانه، إذا ما فقده يفقد إنسانيته ويصبح كسائر المخلوقات الحيوانية
من هنا جاءت الآيات والروايات لتصبّ في مجرى واحد هو التجرّد عن حب الذات (الأنانية) من خلال التفكّر في الحياة الآخرة والعمل لها ويستنكر عليهم القرآن الحكيم ذلك بقوله: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ} [المؤمنون: 115].
ويطلب منه أن يستخدم مفهوم حبّ الذات مفهوماً شاملا يسير به نحو التقدّم والتخلص من الأخطار والمشاكل والتوازن بين الحياتين وهذا مصداقه الدعاء الوارد في القرآن الحكيم: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201].
ويحث على التضحية والعطاء وخدمة الآخرين والجهاد والإيثار برفضه التقاعس عن الجهاد بقوله تعالى: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [التوبة: 39]. فالإنسان لا يستطيع أن يدخل في أعماق النفس الإنسانية ويعرف احتياجها.
لذلك لا بدّ له أن يتبع القوانين التي تكون مقياس أفعاله وتصرّفاته، وميزاناً توزن به الأمور وقد أرشدتنا الروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) حيث جاء في كلام لأمير المؤمنين (عليه السلام) لابنه الحسن (عليه السلام): "يا بنيّ اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحبّ لنفسك وأكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحبّ أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك وارضَ من الناس بما ترضاه لهم من نفسك (22).
ويعني ذلك أن يعرض الإنسان العمل على نفسه ويرى هل يرتضي أن يكون هو الشخص الذي يقع عليه ذلك العمل، مثلاً أنت لا تحبّ أن يغتابك الناس فهذا يجعلك لا تغتاب الناس، وتحب ألّا تهان فلا تهن الناس.
وقد رُويَ أنّ شاباً جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إنّي أحبّ الزنا، فقال له الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله): أتحبّ أن يفعل ذلك بأمك، قال الشاب: لا، قال (صلى الله عليه وآله): أتحبّ أن يفعل بأختك، قال: لا، فقال (صلى الله عليه وآله): إذاً لا تزنِ.
فخرج الشاب وليس شيء أبغض عنده من الزنا، مع أنّه دخل ولم يكن شيء أحب إليه من الزنا.
وهكذا إذا قاس الإنسان كلّ عمل على نفسه وجعلها ميزاناً فسوف لا يفعل الأعمال القبيحة وينفتح على المجتمع بتجرده عن التمحور حول ذاته واقتلاع هذا المرض من داخل النفس الإنسانية وهذا بداية لتغيير ما بداخل النفس وبذلك يتغير الفرد والمجتمع، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الرعد: 11].
إنّ أهل البيت (عليهم السلام) وتعاملهم مع الحياة خير نموذج لنا فنحن نقرأ في القصص التي وردت عنهم من الإيثار والتجرّد عن الذات الشيء الكثير، وهذا القرآن يحدّثنا في سورة الدهر (الإنسان) التي وردت في حق إيثارهم: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا *إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا} [الإنسان: 8، 9].
وقصة هذه الآيات الكريمة تحكي إيثارهم الغير على الذات بأعلى مرتبة وأفضل صورة...
الجمع بين الحاجة المادية والمعنوية:
إنّ الصفات المحمودة ما هي إلّا ملكات تترسّخ في نفس حاملها بالممارسة والمداومة عليها لينفتح بها على مجتمعه ناشراً فيه الفضيلة ومساهماً في بنائه إلى أن يصل به إلى الرقّي، بتخلّصه من حالة الأنانية النابعة من التمحور حول الذات، فالإنسان لا بد له من أن يحبّ ذاته ليجلب لها المنافع والسعادة وهذا أمر طبيعي والإسلام لا يريده أن يضرّ بنفسه أو يبغض ذاته بل إنّ تعاليمه تحذّره من تعريض نفسه للهلاك وذلك في قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195].
وتحمّله مسؤولية الدفاع عن ذاته والاهتمام بها قبل كلّ شيء {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [المائدة: 105].
لكن هذا يكون وفق ضوابط ولا يكون عشوائياً فلو كان عشوائياً فإنّه يعزّز حالة الأنانية المرضية وعبادة الذات التي تنطوي على مساوئ كبيرة قد بيّناها في طيّات البحث وهذا يعني اهتمام الإنسان بجانب واحد فقط وهو المادي، والغفلة عن الجانب المعنويّ حيث هذان الجانبان داخلان في تكوين الإنسان، وفقد الجانب المعنوي منهما يؤدي إلى تجرّد الإنسان من إنسانيّته ويصبح كالبهيمة بتعبير أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبته القاصعة «همّها علفها» وهنا لا بدّ من الرجوع إلى الضوابط وهي حالة التوازن بين الجانبين وهو معنى الدعاء الوارد في القرآن الحكيم الآنف الذكر: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201].
وهي إشارة إلى حالة الجمع بين الحاجة المادية والمعنوية.
فالإنسان الأنانيّ يتوهّم خطأ أنّه يستطيع أن يكون له جوّ خاص وينشغل في جلب الملذّات لذاته، بينما هو يعيش كجزء من مجتمع يتأثر به ويؤثر فيه ويتأثر برأيه العام السائد فيه فمثلاً من الناحية الدينية والأخلاقية لو فكّر الفرد أن يصلح ذاته فقط ديناً وأخلاقاً ولا شأن له بالآخرين فهل يسلم من تأثيرات المجتمع إذا تفشى فيه الفساد واللاتديّن؟ بالطبع كلا، فإنّ الفساد سوف يدخل داره ويؤثّر على عياله بل عليه أيضاً، ويصل إلى حالة لا يستطيع معها ممارسة التديّن وسط مجتمعه فإنّه يمنعه من ذلك وهذا أحد معاني حديث أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيّته للحسن والحسين (عليهما السلام): «لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولّى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يُستجاب لكم» (23).
كما هو مضمون وصيّة رسول الله (صلى الله عليه وآله): "ما كرهته لنفسك فاكرهه لغيرك وما أحببته لنفسك فأحببه لأخيك" (24).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كلمة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله): ص 167.
(2) تحف العقول: ص 8.
(3) نهج الفصاحة: ص315.
(4) الكافي: ج 2، ص 164، ح 5 ط ـ بيروت.
(5) كلمة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله): ص 76.
(6) تصنيف غرر الحكم: ص 394، ط 1.
(7) المصدر نفسه.
(8) مبادئ علم النفس: ص 119.
(9) قصص العرب: ص 155، نقلاً عن بلوغ الأرب: ج 1، ص 81.
(10) نهج البلاغة: كتاب 45، ص 418، صبحي الصالح.
(11) الكافي: ج2، ص 397، ح2، ط 3.
(12) البحار: ج 70، باب 133، ص 291، ح 18، ط ـ بيروت.
(13) نهج البلاغة: خطبة 192، ص 295، صبحي الصالح.
(14) البحار: ج 70، باب 133، ص 293، حد 24، ط ـ بيروت.
(15) تصنيف غرر الحكم: ص 309، ط 1.
(16) البحار: ج 75، باب 22، ص 186، ح 16، ط ـ بيروت.
(17) البحار: ج 70، باب 130، ص 234، ح 37، ط ـ بيروت.
(18) البحار: ج 72، باب 65، ص 214، ح 10، ط ـ بيروت.
(19) تصنيف غرر الحكم: ص 301، ط 1.
(20) الكافي: ج2، ص 306، باب الحسد، ح 2.
(21) الكافي: ج2، ص 302، ح 11، ط 3.
(22) نهج البلاغة: وصيّة 31، ص 397، صبحي الصالح.
(23) نهج البلاغة: كتاب 47، ص 422، صبحي الصالح.
(24) كلمة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله): ص 167.
 الاكثر قراءة في رذائل عامة
الاكثر قراءة في رذائل عامة
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












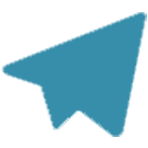
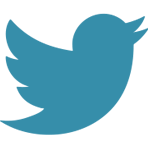

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)