

التاريخ والحضارة

التاريخ

الحضارة

ابرز المؤرخين


اقوام وادي الرافدين

السومريون

الساميون

اقوام مجهولة


العصور الحجرية

عصر ماقبل التاريخ

العصور الحجرية في العراق

العصور القديمة في مصر

العصور القديمة في الشام

العصور القديمة في العالم

العصر الشبيه بالكتابي

العصر الحجري المعدني

العصر البابلي القديم

عصر فجر السلالات


الامبراطوريات والدول القديمة في العراق

الاراميون

الاشوريون

الاكديون

بابل

لكش

سلالة اور


العهود الاجنبية القديمة في العراق

الاخمينيون

المقدونيون

السلوقيون

الفرثيون

الساسانيون


احوال العرب قبل الاسلام

عرب قبل الاسلام

ايام العرب قبل الاسلام


مدن عربية قديمة

الحضر

الحميريون

الغساسنة

المعينيون

المناذرة

اليمن

بطرا والانباط

تدمر

حضرموت

سبأ

قتبان

كندة

مكة


التاريخ الاسلامي


السيرة النبوية

سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) قبل الاسلام

سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الاسلام


الخلفاء الاربعة

ابو بكر بن ابي قحافة

عمربن الخطاب

عثمان بن عفان


علي ابن ابي طالب (عليه السلام)

الامام علي (عليه السلام)

اصحاب الامام علي (عليه السلام)


الدولة الاموية

الدولة الاموية *


الدولة الاموية في الشام

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

معاوية بن يزيد بن ابي سفيان

مروان بن الحكم

عبد الملك بن مروان

الوليد بن عبد الملك

سليمان بن عبد الملك

عمر بن عبد العزيز

يزيد بن عبد الملك بن مروان

هشام بن عبد الملك

الوليد بن يزيد بن عبد الملك

يزيد بن الوليد بن عبد الملك

ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك

مروان بن محمد


الدولة الاموية في الاندلس

احوال الاندلس في الدولة الاموية

امراء الاندلس في الدولة الاموية


الدولة العباسية

الدولة العباسية *


خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى

ابو العباس السفاح

ابو جعفر المنصور

المهدي

الهادي

هارون الرشيد

الامين

المأمون

المعتصم

الواثق

المتوكل


خلفاء بني العباس المرحلة الثانية


عصر سيطرة العسكريين الترك

المنتصر بالله

المستعين بالله

المعتزبالله

المهتدي بالله

المعتمد بالله

المعتضد بالله

المكتفي بالله

المقتدر بالله

القاهر بالله

الراضي بالله

المتقي بالله

المستكفي بالله


عصر السيطرة البويهية العسكرية

المطيع لله

الطائع لله

القادر بالله

القائم بامرالله


عصر سيطرة السلاجقة

المقتدي بالله

المستظهر بالله

المسترشد بالله

الراشد بالله

المقتفي لامر الله

المستنجد بالله

المستضيء بامر الله

الناصر لدين الله

الظاهر لدين الله

المستنصر بامر الله

المستعصم بالله

تاريخ اهل البيت (الاثنى عشر) عليهم السلام

شخصيات تاريخية مهمة

تاريخ الأندلس

طرف ونوادر تاريخية


التاريخ الحديث والمعاصر


التاريخ الحديث والمعاصر للعراق

تاريخ العراق أثناء الأحتلال المغولي

تاريخ العراق اثناء الاحتلال العثماني الاول و الثاني

تاريخ الاحتلال الصفوي للعراق

تاريخ العراق اثناء الاحتلال البريطاني والحرب العالمية الاولى

العهد الملكي للعراق

الحرب العالمية الثانية وعودة الاحتلال البريطاني للعراق

قيام الجهورية العراقية

الاحتلال المغولي للبلاد العربية

الاحتلال العثماني للوطن العربي

الاحتلال البريطاني والفرنسي للبلاد العربية

الثورة الصناعية في اوربا


تاريخ الحضارة الأوربية

التاريخ الأوربي القديم و الوسيط

التاريخ الأوربي الحديث والمعاصر
زيارة الإسكندر الأكبر لِوَاحة سيوة والغرض منها
المؤلف:
سليم حسن
المصدر:
موسوعة مصر القديمة
الجزء والصفحة:
ج14 ص 40 ــ 57
2025-07-11
34
تعد رحلة الإسكندر الأكبر إلى واحة سيوة لزيارة معبد «آمون» ثاني حدث عظيم وقع في مصر في أثناء مكثه فيها، وتدل شواهد الأحوال على أن الإله «آمون» في واحة سيوة لم يكن له شأن يذكر في العهد المتأخر من تاريخ مصر إلى أن جاء الملك «أوكوريس» وأخذ في إيحاء عبادة هذا الإله، وهذا الملك يعد أول ملك مصري ظهر اسمه في النقوش المصرية على معبد هذه الواحة، فمنذ زمن أعيد بناء معبد «أغورمي» الذي لم يكن في الواقع على الطراز المصري ومنذ عهد «أوكوريس» أصبح ذا طابع مصري (راجع: A. Z. 69, P. 1 FF, P. 7 FF & P. 21 F). ولم يكن زحف «أوكوريس» على الجزء الغربي من بلاده إلا سياسة خارجية؛ إذ لا نزاع في أن واحة «آمون» هذه لم يكن لها معنى وقتئذ لدى مصر والمصريين فقد قال أحد المؤرخين (راجع مصر القديمة الجزء 13): إن واحة «آمون» ليس لها على ما يظهر علاقة بآمون المصري ولكن كانت مكانته ثانوية؛ إذ قد حل محله بوساطة الفينيقيين إلههم المسمى «بعل هامون» وهذا الإله قد طُوِيَ في عالم النسيان (أقرن كتابة واحدة «آمون» بتشديد الميم بكتابة «آمون» المصري بميم غير مشددة) والواقع أن واحة «آمون» كانت بالنسبة للمصريين عند قرن إلهها «بآمون» طيبة شيئًا لا يذكر، ولكن من جهة أخرى كانت لها قيمتها عند المصريين من الوجهة السياسية العالمية، وبخاصة أن «آمون» الصحراء الذي كان على الطريق الموصل إلى «كرنيقا» منذ القرنين السادس والخامس، على جانب عظيم من الأهمية البالغة فقد طلب إليه «كروسوس» المشورة قبل هجومه على «كورش» (راجع: Herod. I, 46) وقد وفر على «قمبيز» كما قيل نصرًا يستحق الذكر، هذا وقد أهدى الشاعر الإغريقي «بندر» «آمون» اللوبي أنشودة، (راجع: Frag. 36 Schroeder; Cf. Pind. IX, 89; Pausanias, IX, 16, 1.) وكذلك أرسل «كيمون» الإغريقي قبل ذلك بقليل (450-449ق.م) إلى «آمون» رسولًا لاستشارته (راجع: Plut. Kimn. 18) كما سعى «ليسندر» لغرض في نفسه ليجعل «آمون» في خدمته (راجع: Diod. XIV, 13, 5). وقد كان من جراء اهتمام الفرعون «أوكوريس» وحمايته لهذا الإله أن علا نفوذه في كل العالم الإغريقي، ومن ثم نفهم أهمية زيارة الإسكندرية لهذا الإله، فإنه كان قِبلة الملوك والشعراء من الإغريق وغيرهم، كما كان يعد عند المصريين أعظم الآلهة وأرفعها قدرًا فأراد الإسكندر أن يجعله سُلَّمًا يرقى فيه لما تصبو إليه نفسه من مجد وفَخَار، والواقع أن أعماله العظيمة التي أتمها في مدة ثلاث السنوات الأخيرة قد فاقت ما يمكن أن يصل إليه فرد من البشر، ولا شك في أن الآلهة على زعم الأقدمين قد حابته بحسن حظ متلاحق حتى إنه شل قوة أعدائه وقضى على آمالهم لدرجة أنهم نظروا إلى شخصيته على أنه فوق شخصيات البشر، وكان هذا هو التفسير الطبيعي لمثل حياة الإسكندر التي تخطت حدود حياة البشر (راجع: Diod. XVIII, 36). ومن ثم أخذ الإسكندر يُرجِع بصره للأساطير التي كانت تنطوي على ضروب البطولة وبخاصة سلفيه «برسيوس» Perseus و«هيراكليس» ليجد لنفسه نظيرًا يلائمه في حياة الآلهة، وذلك بعد أن أخذه الغرور بنفسه (راجع: Arrian III, 3, 2) وتدل شواهد الأحوال على أنه صار ابن «زيوس» مثلهما وأنه لا فرق بينه وبينهما إلا أنه خلق من طينة بشرية اسمًا، ومن أجل ذلك وطد العزم على أن يذهب ويؤكد هذه الحقيقة باستشارة وحي «زيوس آمون» وقد أكد لنا المؤرخ «كاليستنيس» الذي كان يرافق الإسكندر ضمن حاشيته وقتئذ أن فكرة استشارة هذين البطلين لوحي «آمون» قبل شروعهما في أعمالهما العظيمة كانت من الأسباب الرئيسية التي حثت الإسكندر على القيام برحلته لواحة «آمون» في سيوة (راجع: Strabo. XVII, 814) وقد كان في الواقع يقصد من هذه الزيارة كما سنرى أن يكون فرعون مصر وإلهها حتى تخضع له مصر كما خضعت للفراعنة الذين سبقوه.
وقد استعرض كل من المؤرخين «أريان» و«إسترابون» بصورة حسنة على حسب ما ذكره المؤرخ «كاليستنيس» الدوافع التي جعلت الإسكندر يصمم على الوقوف أمام وحي «لوبيا» وكان قد مَثُل أمامه من قبلُ كل من «برسيوس» و«هيراكليس» وتقول تقاليد سلالة الإسكندر أنه منحدر من نسليهما في آن واحد، وكلاهما ابن «زيوس» وامرأة من البشر، وكان جده الذي زاره على غرار أجداده أنصاف الآلهة (راجع: Callisthenes, Frag. dans Muller-Diot. Scriptones rerum Alexandrie Magni, P. 26-27; Cf. Strabo, XVI, 1, §. 43, P. 813; & Arrian Anabase III, §. 2).
وقد كانت واحة سيوة يحتلها المصريون خلال العهد الطيبي، وكان مثلها كمثل كل المستعمرات الطيبية يحميها نفس حامي العاصمة أي «آمون» أو «آمون رع» )راجع: A.Z.1877.7.14–17) والواقع أنه لو كانت رغبة الإسكندر في أن يكون ابن الإله «آمون» وحسب لكان في إمكانه أن يحصل على ذلك من كهنة الكرنك بدلًا من قيامه بالرحلة الشاقة التي كانت تكنفها المخاطر في الصحراء وذلك برحلة نيلية ممتعة، ولكن «آمون طيبة» لم يكن معروفًا خارج دائرته إلا من القليل، وعلى ذلك لن يكون لرحلة الإسكندر نفس الصدى الذي يريد أن يحدثه في ذهن العالم الإغريقي وغيره وقتئذ، وذلك لأنه كما ذكرنا سابقًا كان إله الواحة موضع استشارة الإغريق منذ قرون مضت، وقد تغنى بمدائحه شعراؤهم وتمدَّح بمناقبه مؤرخوهم، وإذا كان هذا الإله قد ظل يحمل اسم «آمون» عند المصريين فإنه كان يسمى في الممالك الأخرى التي على ساحل البحر الأبيض المتوسط باسم «زيوس» وذلك لأن الإله «زيوس» الذي أصبح مرادفًا لآمون كان في مقدروه أن يتحدث إلى البلاد الهيلانية وهي من ناحيتها تصغي إليه، ولقد كان من واجب «آمون» أن يرشد «الإسكندر» إلى نفس الطريق التي يصل بها إلى تأليهه كما وصل الفراعنة من قبل ذلك، ونحن نعلم بصورة عامة مما وصل إلينا من كثير من الكُتاب معاصري «الإسكندر» مثل «كاليستنيس» و«بطليموس بن لاجوس» ومن المحتمل كذلك «أرستوبوليس» الذين رافقوه في رحلته.
فقد تحدث كثيرًا «بطليموس الأول» عن حوادث هذه الرحلة إلى واحة سيوة ووصفها لنا، ومن بين القصص الغريبة في ظاهرها أسطورة مقابلة رجال الرحلة الثُّعَبَانَيْنِ اللذين أرشدَا المقدونيين إلى الطريق السوي بعد أن ضلت الرحلة السبيل في مجاهل الصحراء، وكذلك يعزو «كاليستنيس» إرشاد حملة الإسكندر إلى السبيل الصحيحة إلى غُرَابَيْنِ، وقد عزز قوله هذا ما ذكره لنا «أرستوبول» وغيره (راجع: Callisthenes, Frag. 27 in Muller Scriptones rerum Alexandri Magni. P. 26-27).
والواقع أنه لا يوجد كثير من بين القدامى أو الأحداث ممن يفهمون كيف يمكن لإنسان من طراز «بطليموس» أن يصدق مثل هذه الأعجوبة، وقد حاولوا أن يفسروا أمثال هذه الظواهر بوسائل عليا فوق طاقة فهم البشر، وقد كان الأجدر بهم أن يفحصوا عن صحة هذا الحادث وأن الصورة المبالغ فيها وهي التي رواها المؤرخون الذين جاءوا فيما بعد تخفي في طياتها حقيقة بسيطة في الأصل، فقد قص علينا أحد الأوروبيين من القلائل الذين اخترقوا الصحراء في أيامنا قاصدين واحة «آمون» كيف أنه ذات ليلة قد واصل مرشده السير لمدة من الزمن، وبعد ذلك رأى غُرَابَيْنِ يحلِّقان في الفضاء لمدة قصيرة ثم طارا نحو الجنوب الغربي؛ أي في اتجاه واحة «آمون».
وقد أضاف هذا السائح قوله: إذا كنا قد عشنا في عصر الأساطير لكان في مقدورنا أن نرى في ذلك علامة كافية للطريق السوي وتتبعنا هذين المرشدين الخيِّرَيْن، ومن يدري؟ فقد يكونان من الغِرْبان المتناسلة من تلك التي دلت الإسكندر إلى واحة «آمون» وخلصته من أهوال عزلة لا سبيل فيها، والواقع أننا كنا لا نضل الطريق لو اقتفينا أثر الغرابين ولكِنَّا فضلنا ألا نستسلم للخيال وانتظرنا عودة البدوي مرشدنا )راجع: Balyle Saint John, Adventures in Libyan Desert and the Oasis of Jupiter Ammon, P. 69).
هذا وكان على جيش من الفرسان يقطعون الصحراء بطبيعة الحال أن يطلقوا حيوانًا من كل نوع وكانت هذه طريقة على ما يظهر لإرشادهم، وكان يكفي ظهور غرابين أو ثعبانين أو هما معًا لإرشاد الحرس إلى الطريق التي فقدوها ليجعل الإغريق دون انقطاع يرصدون الإشارات الضئيلة التي تكشف لهم عن تدخل الآلهة في أحوال البشر، وهي اعتبار هذه الأشياء بمثابة رسل أرسلها «آمون» إلى ابنه «الإسكندر» أما المصريون واللوبيون الذين كانوا يُقَدِّرون «الإسكندر» ورجاله فإنهم كانوا على معرفة تامة بهذه الأساطير الخاصة بالحيوانات التي تساعد البشر والتي كانت تنقلهم إلى عالم الآخرة، وكان المصريون ينسبون ذلك على الأقل إلى ست من الحشرات أو الطيور (وهي الزنبور والجرادة وفرس النبي والأوزة وبنت البحر والصقر) وكان عليها أن ترشد الأرواح على رمال لوبيا حتى الأقطار التي تسكنها الأموات الأوزيرية )راجع: Lefebure, Etude sur Abydos in Proceedings of the Society of Biblical Archeology, 1892-1893, Vol. X. P. 135–151).
على أنه في أيامنا هذه نجد أن الجَمَل يتجه نحو المكان الذي فيه الماء في الصحراء على مسيرة عشرة أيام، ومن ثم نرى أن دهشة القدامى والأحداث لا مبرر لها؛ إذ الواقع أن زحف الثعابين وطير الطيور أمام الجيش كان أمرًا عاديًّا في حد ذاته، ولا بد أن «بطليموس الأول» كان متعمقًا جدًّا في آراء زمنه لدرجة أنه لم يقبل عن طيب خاطر التدخل الإلهي الذي نُسِب لآمون في هذا الحادث، والواقع أن التفاصيل الغريبة التي نسجها خيال الكُتَّاب حول هذا الحادث قد ظهرت له غير محتملة الوقوع ولم يذكر لنا «بطليموس» إلا عبارة قصيرة عن استقبال الفاتح، وقد أظهر الإسكندر نفسه في صورة الرجل الحازم واقتصر على أن قرر أن الإله قد منحه الجواب الذي يرغب فيه وحسب)راجع: Arrian Anabase. III, IV, §. 5.) (1)
وقد ذكر لنا «كاليستنيس» عن هذه الرحلة أكثر مما ذكره «أريان» وإليه يرجع الفضل في أنه أصبح في إمكاننا أن نتصور على وجه التقريب المقابلة التي كانت بين «آمون» والإسكندر، ولا شك في أن الحفل كان غريبًا في نظر الإغريق الذين زاروا المعبد مع «الإسكندر» وذلك لأن تمثال الإله «آمون» الذي نصب في قدس الأقداس كان كتلة من الزمرد وكثير من أنواع الأحجار نصف الكريمة الأخرى، هذا إلى أن الطريقة التي كان يستشار بها وحي «آمون» كانت غريبة، فقد كان يُقعِد التمثال في وسط قارَب كبيرٍ مُذَهَّب يكلَّف بحمله ثمانون كاهنًا على أكتافهم عند مغادرة الإله المحراب، وكان التمثال عند مخاطبته يومئ إلى حامليه بإشارة برأسه على الطريق التي يريد أن يسلكها، وكان يرافقه جمٌّ غفير من النساء والعذارى على طول الطريق منشدين الأناشيد بلغة أمهاتهن، ولم يسمح الكاهن الأعظم إلا للإسكندر وحده بالدخول في المعبد بملابسه العادية أما أتباعه فقد حتم عليهم أن يغيروا ملابسهم ويقفوا خارج المحراب، في حين أن سيدهم قد دخل المحراب ليسمع مصيره، وعندما وقف الإسكندر أمام الباب قابله وَحَيَّاه قائلًا: «يا بني.» وقد قيل له إن هذه التحية جاءته من قبل الإله، وقد أجاب الإسكندر بقوله: «إني أتقبل هذا اللقب يا والدي، ومنذ هذه اللحظة سأدعو نفسي «ابنك»، فهل تمنحني أن أملك الأرض قاطبة؟» ثم دخل الكاهن في المحراب وأدخله فيه معه، أما الرجال الذين كانوا يحملون القارب المقدس فأخذوا يتحركون بإشارة من الإله وبكلمة منه، والظاهر أن «آمون» في معظم الأحيان لم يكن يعبر عن إرادته بالكلام مثل ما يفعل «أبولون دلفي» أو «أبولون براخيدس»، ولكن مثل زيوس «دودوني» Dodone (وهي قرية قديمة في «أبيروس» بالقرب من قرية «دراستي» الحالية، وكان فيها معبد للإله «جوبيتر» بالقرب من غابة بلوط وكان يؤدَّى فيها الوحي).(2) VII Fragm وكان يجيب على الأسئلة التي توضع له بإيماءات برأسه أو بإشارات متفق عليها، ولا نزاع في أن الكاهن (خادم الإله) كان هو الذي يقوم بدور المترجم، ولكن في هذه المرة تكرم الإله بالكلام، وعندما خاطب الكاهن الأكبر التمثال ووضع له السؤال أعلن التمثال بقوة أنه منحه ما يرجوه، فسأل الإسكندر: إذا كان هناك فرد من قتلة والده قد أفلت من العقاب، فصاح الكاهن: لا تسب الدين قط؛ لأنه لا يمكن لبشر أن يأتي شيئًا ضد والدك، وعلى إثر ذلك غيَّر صورة السؤال الذي وضعه أولًا وقال: هل كل قتلة «فليب» قد لاقوا عقابهم؟ فأكد له الإله أنهم كلهم قد لاقوا جزاءهم، ثم أضاف أن النصر سيكون له حليفًا أمينًا في المستقبل، كما كان في الماضي، وكان الإسكندر مرتاح البال راضيًا بكل ما قيل له؛ ومن أجل ذلك أغدق على الإله وكهنته هبات فاخرة) راجع مختصَرًا لهذه القصة في .(Strabo XVI, 1, §. 43. P. 813
ولا نزاع في أن هذا المنظر يعبر عن حقيقة أخاذة لأولئك الذين اعتادوا المناظر الدينية المصرية؛ إذ الواقع أن الحفل والخطاب، كلاهما يتفق مع الشعائر المصرية التي كانت تقام في المعابد، ويمكن الإنسان أن يتتبع تطور هذا الموضوع مرحلة مرحلة في المناظر المصرية القديمة وفي النقوش الهيروغليفية أيضًا.
والقليل الذي بقي لنا من خرائب معبد واحة سيوة يعطينا فكرة واضحة جدًّا عن معبد يشبه معبد الواحة الطيبية الكبرى، وهي التي وصل إلينا عنها أوصاف مفصلة كثيرة ومعلومات دقيقة (3).
ولا بد من أن نلحظ هنا أن متن الواحة الخارجة هو المتن الذي يقدم لنا بصفة تامة صورة مفهومة عن عبادة «آمون» في الواحة، ولا بد من أن معابد الواحة كانت قد أُصلِحَت وزِيدَ فيها في العهد الفارسي وما بعده كما ذكرنا آنفًا، ولما كان «آمون» هو نفس الإله الذي كان يعبد هناك في كل بقعة فإن التصميم العام لمعبد «آمون» وترتيب أجزائه هنا كان واحدًا، فقد كان «آمون» يعيش في ظلام دامس في آخر حجرة بالمعبد؛ أي في «قدس الأقداس»، وكان قاربه موضوعًا على مذبح، أو بعبارة أخرى على قاعدة من الحجر أو من الخشب مكعبة الشكل في وسط «قدس الأقداس».
وهذا التمثال كان يصنع من الذهب أو على حسب التعبير الكلاسيكي من الخشب المغشَّى بالذهب (راجع: Diod. XVII, 50, § 6) وكان لا بد من أن يكون طوله أقل من طول الحجرة التي تحتويه بمترين أو ثلاثة، ومن أراد أن يرى هذا التمثال مصورًا فما عليه إلا أن يرى صوره في معبد الأقصر أو في معبد الكرنك بكل تفاصيلها ومعها التعابير التي استعملها «كاليستنيس» في وصف التمثال، وقد جاءت غاية في الدقة، فقد قال إنه كتلة من الزمرد والأحجار الأخرى الثمينة، ومن ثم يجب أن نتصوره كما نتصور أحد تلك الأصنام المركبة التي أتى ذكرها في متون دندرة مثلًا فكان جسمه يحتوي على قطع من مواد مختلفة رُكِّبَت على أصل من الخشب أو البرونز، ولا أدل على ذلك مما جاء في أحد متون «دندرة» من تعداد المواد المعدنية وبخاصة الأربعة عشر جزءًا التي يُصنَع منها جسم أوزير (راجع: Mariette Dendarah, P. 127, & t. IV, Pl. 36, 1. 54, 599, t. III, Pl. 30C. I. 6–73).
والزمرد الذي كان شائع الاستعمال وقتئذ لم يكن على وجه التأكيد الزمرد الحقيقي الحديث بل كان من «الفلدسبات الأخضر» المصري، وقد كانت تماثيل الوحي تُصنَع بطريقة تجعلها تجيب بعدة حركات كهز الرأس وتحريك الذراعين أو اليدين وفي العادة كانت التماثيل تجيب عن الأسئلة برفع الرأس أو بجعله ينحني بثقل مرتين، وكان يراد من التمثال أن يجيب في حالة الإثبات بكلمة «نعم» ولكن عند النفي كان التمثال يبقى دون حركة.
وكان التمثال يتكلم أحيانًا، ولكن ذلك كان نادرًا، وبخاصة عندما كان يخاطبه ملك، وعندئذ كان يسمع صوته يدوِّي في نهاية المحراب، هذا وكان هناك كاهن يشد الحبل الذي يجعل الرأس أو الذراعين تتحركان إشارة إلى ما يريده الوحي، وقد كان كل واحد يعرف تلك الحيل التي يقوم بها الكاهن، ومع ذلك لم يكن هناك من يتهم هذا الكاهن بالغش أو بسوء النية، زعمًا بأنه آلة للإله ولكنه آلة مسيَّرة لا مخيَّرة ولا تعي شيئًا، وكان الكهنة يزعمون أن الروح الأعلى يسكن الكاهن في اللحظة المرغوب فيها الإجابة وعندئذ كان يهز الخيوط أو يحرك شفتيه، ومن ثم فإنه كان يحرك يديه أو يتكلم، ولكنه هو الإله الذي كان يملي عليه هذه الإشارات أو يوحي إليه بالكلمات )راجع:( Maspero Etudes de Methol. I. P. 81–91 راجع كذلك مصر القديمة الجزء التاسع حيث تجد كلامًا مفصلًا عن الوحي منذ بدايته، وبعد تقرير كل ما سبق هنا يمكن الإنسان أن يفحص عن كل الحفل على ضوء الأصول المصرية القديمة التي كانت متبعة، فإذا كان الإسكندر فعلًا فرعونًا حقيقيًّا قد تعلَّم منذ نعومة أظفاره واجبات الفرعون وامتيازاته التقليدية في هذه المناسبة فإنه كان عليه أن يذهب مباشرة إلى المعبد ويقوم بشعائر احتفال التتويج كما وردت لنا مثلًا في لوحة بيعنخي، وهاك النص حرفيًّا: «ثم سار (أي الملك) إلى «تل الرمال» في «عين شمس» وهناك قرَّب قرابين عظيمة على تل الرمال في «عين شمس» في حضرة «رع» عند طلوعه وتحتوي (أي القرابين) على ثيران بيضاء ولبن وعطور وبخور وكل خشب ذي رائحة جميلة، وحضر متجهًا إلى بيت «رع»، ودخل المعبد بدعاء عظيم وتضرع الكاهن رئيس المرتلين للإله أن يصد الثوار عن الملك، ثم زار قاعة الصباح لأجل أن يرتدي لباس «سدب» (وهو لباس يتمنطق به الملك)، وطهر بالبخور والماء، وقُدِّمت له أكاليل لأجل بيت لهرم الصغير، وكذلك أُحضرت له الأزهار، وصعد السلم إلى النافذة العظيمة ليشاهد «رع» في بيت «بن بن» (الهرم الصغير)، وقد وقف الملك نفسه منفردًا وكسر المزلاج حين فتح المصراعين وشاهد الوالد «رع» في بيت «بن بن» الفاخر وسفينة الصباح الفاخرة ﺑ «رع» وسفينة المساء الخاصة ﺑ «أتوم»، ثم أوصد المصراعين ووضع عليهما الطين وختمهما بخاتم الملك نفسه وكلف الكهنة المصريين قائلًا لقد فحصت الخاتم ولن يُسمَح لأي فرد آخر أن يدخله … إلخ.» (راجع مصر القديمة الجزء الحادي عشر).
ولكن الإسكندر لم يكن يعرف شيئًا من كل ذلك وقد فطن الكهنة إلى ذلك ورأَوا أنه من غير الضروري أن يقوم بهذه الشعائر الطويلة الدقيقة بل عاملوه معاملة حاجٍّ عاديٍّ، وفضلًا عن ذلك لم يطالبوه بشعيرة الطهور المعتادة التي كان يقوم بها الأفراد العاديون، ولكنهم فرضوها على رفاقه، وزيادة على ذلك طبقوا عليهم قاعدة تحريم الاقتراب من حجرات المحراب، وهي التي كانت محرمة على الإغريق والأجانب، وعلى ذلك دخل الإسكندر وحده مع قائده المقدس (الكاهن)، وعند أسكفَّة المعبد ألقى الكاهن الخطبة القصيرة التي يلقيها الإله على كل الملوك، وهي: تعال يا بني من صلبي الذي أحبه حتى أمنحك أبدية «رع» وملك «حور». أو كانت تلقى صيغة أخرى تبتدئ بنفس الألفاظ السابقة، ومثل هذه الصيغ نجد رواياتها المختلفة على جدران المعابد، ومن المحتمل أن هذه الصيغة كانت قد أُلقيت بالمصرية ثم تُرجمت للإسكندر باللغة اليونانية على ما يُظَنُّ، وذلك لأن العلاقات بين الواحة ولوبيا والبلاد الهيلانية قد جعلت هذه اللغة متداولة عند أهل هذه الجهة.
ومهما تكن طريقة التعبير فإن الصيغة كانت مصرية ولا تشمل إلا التعبيرات العادية الخاصة بالعقيدة والتي كانت تسمي كل ملك في زمنه «الابن المحبوب من كل الآلهة»، وبعد إلقاء شعيرة السلام كان الكاهن يقدم ضيفه أمام الإله، هذا ولم يكن الإله ينتظر الزيارة في المحراب بل كان يخرج أمام الملك وذلك على حسب العادة المتبعة عندما كان يُستشار في مسألة دقيقة خاصة بالسياسة أو القضاء.
هذا ويُلحظ أن الرقم الثمانين الذي أورده «كاليستنيس» دالًّا على عدد حاملي القارب المقدس، مبالغٌ فيه، وذلك أن قوارب المعابد الطيبية كان يحملها اثنا عشر أو عشرون أو ستة وعشرون أو أربعون (راجع: L. D. III, 14, 143, 189 a; Descrip. de l’Egypte, A. T. III, Pls. 2-3).
وإذا كان عدد الكهنة الذين حملوا قارب الإله في معبد الواحة صحيحًا فلا بد أنهم لم يكونوا كلهم يحملون القارب في وقت واحد بل كانوا يتناوبون حمل القارب، وبخاصة عندما تكون المسافة طويلة، هذا ويجب أن نتصور أن القارب كان يقف عند نقطة معينة في المعبد أمام الملك المنتظر ثم يسأل الملك التمثال الذي في الناووس، وقد كان مثل هذا الحفل يُعمَل في الكرنك على رقعة أرض في المعبد تدعى «رقعة الفضة»، ومن المحتمل أنه كان يوجد في كل المحاريب الأخرى ما يشبه «رقعة الفضة» هذه بما في ذلك معبد آمون بسيوة، هذا ولدينا نقش تاريخي يرجع عهده للأسرة الواحدة والعشرين في حكم «بينوزم الثاني» قد اتُّهِمَ فيه موظف كبير بالاختلاس وقد طُلِبَ أمام الإله آمون في قاربه وقد سُئِل الإله فيما إذا كان الموظف مذنبا أو غير مذنب، وقد أصدر الإله حكمه بإشارة برأسه (راجع مصر القديمة الجزء الثامن حيث يوجد هذا الحادث الهامُّ مفصلًا)، والواقع أن نفس الطريقة التي أجريت لاختيار الإسكندر فرعونًا قد تمت بهذه الطريقة، فقد أوقفه الكاهن أمام قارب آمون وسأله أن يضع بنفسه السؤال، ولكن الإله أجاب بصوت جهْوَري لا بالإشارة، وقد كان التأثر الذي سببته الإشارة إلى قاتل «فليب» والد الإسكندر يُفهَم منها — إذا ظن الإنسان الملك هو ابن الإله — أن والده قد قُتِل فإن ذلك يذكرنا بالجريمة الكبرى التي عكرت فيما مضى صفو السماء المصرية وأعني بذلك قتل «ست» أخاه أوزير، أما من حيث وعد الإله «الإسكندر» بالنصر فإننا نجد هذه التعبيرات مذكورة مرات لا عدد لها في خطابات الآلهة مثل:
إني أعطيتك الشجاعة، إني أمنحك السيطرة على كل البلاد وكل الأقطار الأجنبية تحت نعليك … إلخ.
وهكذا فإن كل شيء كان يتفق مع الحفل المصري، وعلى ذلك فإن كل الأمور تظهر أنها حقيقية مما وصل إلينا من المناظر التي نشاهدها رأي العين في المعابد والوثائق المصرية القديمة، وقد أصبح «الإسكندر» بحقِّ الفتحِ فرعونًا، وقد استقبله الإله «آمون رع» بنفس الطريقة التي كان يستقبل بها الفراعنة الشرعيين، وعامله الإله بوصفه ابنه واعترف بأنه والده كما اعترف لذلك لكل الفراعنة الذين سبقوه، ولكن يتساءل المرء هل فهم المقدونيون والإسكندر قيمة هذه الأحفال التي نفذت أمامهم، والواقع أنه من المحتمل أن هؤلاء لم يكلفوا أنفسهم مئونة التعمق في فهم ذلك، بل اقتصروا على تدوين النتيجة وهي الاعتراف بالأبوية الإلهية التي أتوا يبحثون عنها، وقد ترجموها على حسب الآراء الجارية بالنسبة لهذا الموضوع في العالم الإغريقي، ومن المحتمل جدًّا أنهم اعتقدوا أن الرغبة في تملُّق السيد الجديد قد ألهم كهنة الواحة، وهذه العاطفة لها قيمتها في السهولة التي استقبل بها الإسكندر بوصفه «ابن الإله»، ولكن التَّحمس الديني كان له الجزء الأعظم في سلوكه في هذا الموضوع، ويظهر لنا أن هذا الإجراء مهزلة سياسية، ولكنه من المعتقدات اللاهوتية الطيبية المسلَّم بها بل إنه أمر مفروض أن يعمله كل فرعون.
فقد كان الإله «آمون» منذ قرون في طيبة وفي المستعمرات المصرية الإله الأعلى وكذلك الجد الذي يجب أن ينحدر منه كل فرعون حتى يصبح الملك الحقيقي لمصر، ومن البديهي أن هذا الامتياز الذي خُصَّ به «آمون» لم يكن وقفًا عليه في الأصل بل اغتصبه من إله الشمس «رع» إله الدولة الأصلي، ولا نزاع في أن هذا الحفل كان يعقد في الأصل في «هليوبوليس» عند تولية كل فرعون من الأسرة الخامسة فصاعدًا إلى أن ظهرت «طيبة» على «هليوبوليس»، وأصبح إلهها «آمون» إله الدولة، وأطلق عليه اسم «آمون رع» وبذلك أصبح يشارك «رع» في هذا الاحتفال، غير أننا لا نعرف على وجه التأكيد في أي تاريخ حدث ذلك.
وقد كان كل الملوك بوصفهم أولاد «رع» يجري في عروقهم دم «رع» أو إذا كانوا طيبيين فإن دم «آمون رع» كان يجري في عروقهم، وكان على الذين ارتقوا عرش الملك من عامة الشعب أن يعوضوا ضَعة أصولهم بأن يتخرعوا لأنفسهم أنسابًا خارقة لحد المألوف تربطهم بالدوحة الشمسية أو كان يتبعون طريقة أحسن من ذلك وهي أن الطامع في العرش كان يتزوج من إحدى الأميرات التي يجري في عروقها دم «رع» من اللائي يُنسبن إلى الملك مباشرة، وهؤلاء النسوة عندما كنَّ يصبحن أمهات كان أطفالهن يأخذون عنهن الدم الإلهي الذي كان ينقص آباءهم، وبذلك كانوا يربطون من جديد سلسلة الأنساب التي انقطعت لمدة، ويظهر أن من تولى من غير الأسرة المالكة عرش مصر كان يعد بداية أسرة جديدة، وكان هذا المؤسس الجديد يعمل على تثبيت ملكه بزواجه كما قلنا من إحدى قريبات الملك السابق أي من الدم الملكي الحقيقي، وقد كانت التقاليد أو القانون المتبع يقضي بأن تكون الأحقية في الملك على حسب النظام التالي:
(1)أن يكون الوارث للعرش ابن ملك وُلد من زواج ملك بأخته، وكلاهما من الدم الملكي الخالص.
(2)أن يكون الوارث ابن ملك وُلد من زواج ملك ليس من الدم الملكي الخالص بابنة ملك من الدم الملكي الخالص.
(3) أن يكون الوارث للعرش رجلًا قويًّا تزوج من ابنة ملك من دم ملكي خالص.
ومما سبق نفهم أن تولية العرش في مصر لم تكن من الأمور الهينة (راجع مصر القديمة الجزء الأول)، وعندما يتزوج رجل قوي من امرأة من الدم الملكي كان لا يقوم بمهام الملك إلا بوصفه زوج الملكة، ومن ثَمَّ يصبح فرعونًا، غير أن أطفالهما لم يكونوا في نظر الشعب من دم ملكي خالص، ولكن الكهنة بما لديهم من حيل رأَوا حلًّا لهذا المشكل وهو أن يتدخل الإله شخصيًّا، وعملوا على أن يكون الطفل الذي سيئول إليه الملك من هذا الزواج ابن الإله «آمون رع» مباشرة، ومن أجل ذلك كان الإله «آمون رع» يتفضل بالنزول على الأرض ويأخذ صورة الملك ويجتمع بالملكة فعلًا، وعلى ذلك فإن الطفل الذي ينتج من هذا الاتصال المباشر الخارق لحد المألوفة يكون الغسل الطاهر من الإله «آمون» أو من الإله «رع»، والآثار الباقية تقدم لنا أمثلة من هذا النوع من الزواج، نذكر منها صور الدير البحري وولادة «حتشبسوت» (راجع مصر القديمة الجزء الرابع) وولادة الملك «منحوتب الثالث» (راجع مصر القديمة الجزء الخامس).
ولدينا مثال آخر كان مصوَّرًا إلى عهد قريب على جدران معبد «أرمنت» قبل أن تستعمل أحجاره في إقامة معمل السكر في بلدة «أرمنت»(4)، وهذا المنظر يمثل ولادة «قيصرون» بن «كليوبترا» و«يوليوس» قيصر، ونحن نعلم كيف أن «كليوبترا» قد تزوجت من يوليوس قيصر وأنجبت منه قيصرون، ولأجل ألا ينكر أحد أبوة «قيصرون» هذا مثَّلت «كليوبترا» منظر اجتماع «آمون» بها، والغريب أن هذا العمل الجريء لم يشمئز منه أهل الإسكندرية من الإغريق، ولقد كان أمرًا ضروريًّا على ما يظهر أن يقدَّم الأمير الجديد إلى رعاياه المصريين الأصليين بطريقة تتفق مع عاداتهم وشعائرهم المصرية، والواقع أن البطالمة قد تعودوا طوال مدة حكمهم أن يمثلوا الأسر الفرعونية القديمة فأصبحوا يُدعَون أولاد «رع» أو أولاد «آمون» كما كانوا منذ عهد «بطليموس الثاني» يحافظون على الزواج من أخواتهم على حسب القواعد المصرية، وهذا أكبر دليل على اهتمامهم بحفظ الدم الإلهي ظاهرًا على حسب القانون الفرعوني.
ويُلحَظ أنه عندما أتى «يوليوس قيصر» الروماني وطعم النسل البطلمي بدم غريب كانت النتيجة أن كهنة «أرمنت» قد أعلنوا أن الإله في هذه الفرصة كان مخلصًا أيضًا، وأنه وحد بقيصر في الليلة الحاسمة التي حملت فيها «كليوبترا» في «قيصرون»، وأن الأخير كان بعيدًا عن أن يكون دخيلًا، بل كان على العكس يمثل نسل «رع» المباشر، وبهذه الكيفية حل الكهنة بسهولة هذه المسألة العويصة التي حولت ابن إغريقية وابن روماني إلى نسل حقيقي منحدر من صلب الآلهة والفراعنة الذين كانوا يحكمون مصر (5).
هذا وقد كان كهنة واحة «سيوة» المتفقهون في كل العقائد الدينية وفي كل شعائر «آمون طيبة» مجبرين بحكم تقاليدهم على أن يعترفوا بأن الإسكندر كان ابن إلههم، وأنه ابنه الذي وُلِدَ من اختلاط جنسي حدث مع والدة هذا الفاتح، على أن الأمثلة على ذلك لم تكن قاصرة على ما حدث في أمر ولادة «حتشبسوت» والملك «أمنحوتب الثالث» بل هناك أمثلة أخرى.
وإذا كان الكهنة قد طبقوا هذه الحالات على حالة الإسكندر فإن سلوكهم في ذلك لم يكن عليه غبار فيما يخص ادِّعاء كادِّعاء هذا الفاتح، والواقع أن المسألة قد مُثِّلت أمامهم بمثابة قضية منطقية غاية في البساطة، وذلك أنه كان لا يمكن أن يكون في مصر ملوك شرعيون إلا إذا كانوا من أسرة «رع» أو أولاد «آمون» مباشرين أو غير مباشرين، والواقع أن الإسكندر هو الملك الشرعي لمصر، وذلك لأن الآلهة قد سمحوا له أن يستولي عليها بعد أن قهر الفُرس بأعجوبة، ومن ثم فإن «الإسكندر» بطريقة أو بأخرى كان ينتسب إلى أسرة «رع»، وإنه ابن آمون رع، ولا يقِلُّ في ذلك عن الملوك الذين سبقوه، وقد يقال بلا شك إنه في كل الأمثلة التي اقتُبِسَت كان الآباء الأرضيون للملك الذي يدعون أبوة «آمون رع» هم من أعضاء الأسرة الحاكمة، وإنه لا فرق بينهم إلا في نسبة الدم الإلهي، في حين أن والد الإسكندر وأمه كانا أجنبيين عن أيَّة أسرة من الأسر الملكية المصرية، وحتى عن مصر نفسها، ولكن فطنة الكهنة الطيبيين التي كانت قادرة على حل المشاكل قد توقعت حدوث مثل هذه النظرية التي يكون فيها الملك المؤسس للأسرة الجديدة وزوجه ليس لهما أية صلة بالملوك السابقين، وعلى ذلك أجابوا بنجاح على الاعتراضات التي تقف في وجه هذه النظرية، وذلك أن تاريخ مصر الحقيقي لا يقدم لنا حتى الآن أية حالة من هذا النوع، غير أن هناك أسطورة تحدثنا بصورة واضحة عما سكتت عنه الآثار، ولا أدل على ذلك مما قيل عن أصل ملوك الأسرة الخامسة، فقد قيل عنهم إنهم لا يتصلون بأية حال من الأحوال بملوك الأسرة الرابعة كما جاء في أسطورة ورقة فستكار، وإن كانت الكشوف الحديثة الصلة بينهما، وعلى أية حال قيل عن ملوك الأسرة الرابعة إنهم من والد وأم من البشر، ولكن «رع» قد أتى إلى الأم واجتمع بها، وبذلك أصبح أولادها الذين أنجبتهم من نسل «رع» (راجع كتاب الأدب المصري القديم الجزء الأول ص74)، والواقع أن هذه القصة كان الغرض من كتابتها أن تعبر في هذا الموقف كما هي الحال في أي زمان عن الأفكار المتداولة في الزمن الذي كتبت فيه فتظهر بوضوح أن الإله كان في قدرته أن يحدد سلالته بوساطة امرأة من عامة الشعب، وليس لها علاقة بإحدى الأسر المالكة، هذا وكان الإسكندر الأكبر مثله كمثل الملوك الثلاثة الذين وردوا في الأسطورة السالفة فلم تكن أمه أميرة يجري في عروقها الدم الملكي على أن ذلك لم يمنعه مثلهم أن يكون والده هو الإله الذي يجب أن يكون كل ملوك مصر من صلبه، وعلى ذلك يكون له الحق في أن يصبح الفرعون الشرعي.
ومن ثم فإن أصل «أوليمبياس» الهيلاني لم يكن عقبة في أن يجتمع «آمون» بها، على أن مجرد كون الإسكندر يتربع على عرش «حور الأحياء» هو برهان كافٍ لدى الكهنة يؤكد وقوع هذا الاجتماع، وأن ابن «فليب» الذي ليس من صلبه كان في الحقيقة ابن «أوليمبياس» و«آمون».
فهل يا تُرى كان هؤلاء الكهنة قد علموا بالشائعات الغريبة التي كانت منتشرة عن ولادة هذا البطل وأفادوا منها ليحاولوا تفسير التفاصيل العدة التي بقيت غامضة في هذه القصة؟ والواقع أن الشعب المصري الذي اعتاد فكرة هذا الزواج الإلهي قد قبل دون تردد حكم كهنة «آمون»، وعلى ذلك أخذ الأصل الخارق للحد المألوف للإسكندر ليكون موضوع قصة حُشرت في الرواية التي وُضعت على لسان «كاليستنيس» حوالي القرن الثالث بعد الميلاد، وتدل شواهد الأحوال على أن القصة لم تكن في أغلب الظن في الأصل إلا صورة من المناظر التقليدية التي مُثِّلت على جدران معبد الأقصر مثلًا، وقد اقتصرت على أن تظهر لنا كيف أن الإله «آمون» عندما أراد أن يخلص بلاده كلها من الفرس الأجانب الذين ساموها الظلم والخسف، قد أتى ليلًا واجتمع بأوليمبياس، وقد بقي هذا المبدأ سليمًا لمن أراد أن يكون الملك من سلالة إلهية، وقد عزى النعرة الوطنية في هزيمتها أن توهمت أن مصر هي التي فازت بهذا الوضع، وذلك لأن مصريًّا هو الذي أخضعها ثم فتح بعد ذلك العالم ) راجع: Pseudo Callisthenes, II 27 ed. Muller-Diclot, P. 24).
ومما يطيب ذكره هنا هو أن سكان الإسكندرية كانوا خليطًا من الوطنيين والإغريق وكانوا أقل تعودًا على تلك الأفكار الصبيانية في نظرهم بالنسبة للَّاهوت الطيبي، ومن أجل ذلك أخذوا يشككون في هذا الإله الذي قام في وسطهم في رابعة نهار التاريخ وسمح لنفسه أن يغري أصحاب العقول الساذجة كما كانت الحال في زمان «هومر».
وقد كانت عقيدة إفهيمير Evhemere التي تقول بأنه من الممكن أن الفرد العادي يصبح إلهًا قد دب دبيبها في نفوس القوم، فبدلًا من التسليم بأن «آمون» قد نزل إلى مخدع ملكة، وهو قول لا يحتمل التصديق، يمكن أن تحل فكرة أخرى محل ذلك وهي أن رجلًا عالمًا كان يتمثل بما أوتي من مهارة في علم السحر في صورة «آمون» لمدة، ولما كان من الضروري أن تصبح الخرافة مقبولة فإن هذا الرجل كان لا بد أن يكون مصريًّا ومن سلالة فرعونية، ولذلك فكر في أن يكون هذا الرجل هو آخر الفراعنة الوطنيين الذين حكموا مصر وهو الملك «نقطانب الثاني» الذي كان صاحب شهرة في فن السحر، وقد كان من المعلوم أنه هرب إلى خارج بلاده (6) بعد هزيمته على يد الفرس واستيلائهم على مصر، وتؤكد المصادر التاريخية أنه كان قد فر إلى بلاد «كوش» واحتمى بها، غير أن التاريخ قد أخطأ في هذه المسألة كما أخطأ في كثير غيرها على زعمهم فقد أرسل الملك المخلوع إلى «مقدونيا» لأجل أن يصير فيما بعدُ والد الإسكندر، وقد كانت الشائعة عن علمه بالغيب قد وصلت إلى أذن «أوليمبياس»، وقد استشارته وقد وقع في غرامها عندما رأى مُحيَّاها الفتان، وقد أخبرها أن القدر قد جعل من نصيبها شرف الاجتماع بإله لتنجب منه ابنًا، ثم أضاف قائلًا إن هذا الإله هو «آمون لوبيا» صاحب الشَّعر واللحية الذهبيين وذو القرن الذهبي: «أَعِدِّي نفسك لاستقباله يا أيتها الملكة؛ لأنك سترين هذا اليوم نفسه هذا الإله يأتي إليه في حلم»، وقد أرسله لها حقًّا بالطرق السحرية التي كانت في متناوله في منام رأت فيه الإله بين ذارعيها، وقد أعلنها هذا الإله بولادة ابن يفوق البشر، ولما كانت الملكة قد اقتنعت بهذه الرؤيا الكاذبة رضيت بأن تستعد للزواج الإلهي، ولكنها سألت عن العلامات التي تتعرف بها على حضور العاشق السماوي، فقال لها عندما ترين ثعبانًا يدخل في حجرتك ويصل زاحفًا نحوك مُرِي بأن يخرج كل مساعديك، ثم اضطجعي على سريرك الملكي وانظري إذا كنت تتعرفين على الوجه الذي رأيته في حلمك، ثم حصل «نقطانب» على جزة كبش له قرون مذهبة وعلى صولجان من الأبنوس وعلى جلباب أبيض وبما أوتيه من مهارة في علم السحر ظهر بمظهر ثعبان هائل، وعندما جاء الليل دخل حجرة النوم التي كانت «أوليمبياس» تنتظره فيها مبرقعة ممتدة على سريرها، وعندما لمحته في ضوء المصباح لم تَخَفْه قط بل لاحظته بدهشة من طرف عينيها، ثم وضع الخيال صولجانه واتخذ له مكانًا وأتم الزواج بها، وبعد ذلك ضغط بيديه على يد الملكة قائلًا: «افرحي أيتها المرأة؛ لأنك حملت مني في ذكر سينتقم لك وسيكون ملكًا سيدًا على العالم. » (راجع: Pseu do Callisthenes, IV-XXII. ed Muller Didot, p. 4–12).
وبعد ذلك أخذ صولجانه واختفى، ولكنه عاد في الليالي التالية كلما رغبت في لقائه، وليس من المهم أن نذكر هنا المعجزات التي ساعد بها «نقطانب» الملكة «أوليمبياس» على أن تجعل «فليب» يقبل حقيقة هذا الزواج الإلهي وبراءته، وقد كان الساحر يوم الوضع بجوار الملكة يفحص السماء، وقد أجبرها مرتين متتاليتين على أن تؤخر الوضع إلى أن يرى لحظة يكون فيها تقابل النجوم يؤكد للطفل ملك العالم قاطبة.
ومما سبق نفهم أن البداية كانت قصة سحر وُضعت لتفسر اختلاس «نقطانب» وكل ما فيها يتفق مع الآراء والشعائر المصرية الخاصة بالعصر، فنجد فيها الفرعون يمارس عملية السحر الخاصة بالحب على حسب الصيغة الأكثر فاعلية فكان يصنع تمثالًا صغيرًا لمرأة من الشمع ثم يكتب عليه اسم الملكة ويجعله ينام على نموذج سرير صُنع خاصة لهذا الغرض، وبعد ذلك يشعل بالقرب منه المصابيح السحرية، ثم يصب على عيني التمثال الصغير عصارة نباتات مختلفة قوية المفعول نشأت عنها أحلام، وبعد ذلك يتلو تعويذة جبارة تجعل الملكة تنام وتخضع في منامها لكل الأعمال التي دوَّنها على تمثاله الصغير )راجع: Ibid. V ed. Muller-Didot. P. 5-6).
ونفس هذه الطريقة كانت مستعملة منذ أزمان بعيدة عند قدماء المصريين، ولا أدل على ذلك مما حدث في عهد الفرعون رعمسيس الثالث (راجع مصر القديمة الجزء السابع) هذا وهناك تعاويذ سحرية أخرى خاصة بالحب.
أما الثعبان الذي تقمصه «نقطانب» فلم يكن شكله معروفًا في العهود الفرعونية، ولكنه كان عاديًّا جدًّا عند أهالي الإسكندرية) راجع: Pseudo-Callisthenes I, XII, ed. Muller-Didot, P. 34).
حيث نجد التقاليد الخاصة بالثُّعبانَيْنِ Agathodemon d’Alexandri في عصر كانت عبادة الثعبان «أجاتوديمون» قد أصبحت مسيطرة على كل وادي النيل، وحيث نجد الآلهة المحليين كان يصاحبها ثعبان رأسه رأس الحيوان المقدس لكل من هذه الآلهة.
هذا وقد فكر من نقل عن «كاليستنيس» هنا أن الثعبان «أجاتوديمون» هو الإله «آمون» أي ثعبان برأس كبش يلبس نوعًا من العباءات أبيض اللون، وحاملًا على جسمه صولجانًا برأس كوكوفا Koukoupha كما نشاهده ممثَّلًا على كثير من الآثار، وهذه الفكرة كان وحيها بطبيعة الحال مستمَدًّا من الشائعات الخفية التي كانت منتشرة منذ البداية عن «أوليمبياس» وعن الألفة التي أظهرتها للثعابين، وتدل شواهد الأحوال على أن منظر الزواج الإلهي قد نُقل حرفيًّا عن أصل مصري، والواقع أننا إذا فحصنا مناظر الأقصر لوجدنا فيها «آمون رع» سيد الكرنك يأتي مسلَّحًا بصولجانه ومُحلًّى بشارات إلهيته لينضم إلى الملكة «موت أم ويا» أم «أمنحوتب الثالث» وبعد ذلك بلحظة نجد الإله والملكة على السرير وقد التفت الساق على الساق، والأقدام تسندها كل من الإلهتين «نيت» و«سلكت» وهما الإلهتان اللتان تشرفان على الزواج.
ويقول أحد النقوش التي تتبع الصورتين إن آمون قد تقمص صورة تحتمس الرابع زوج الملكة وإنه قد وجدها نائمة في قصرها وقد استيقظت على عطور الإله وأنها أعجبت بجلالته، وقد جاء ليجد متعته معها، وإنه قد ظهر لها في صورته الإلهية وعندما وقف أمامها بهره جمالها وذلك لأن حب الإله قد استولى على كل أعضائها وعبير الإله وكذلك أنفاسه كانت معطرة ببخور «بنت» وعندما عادت إلى رشدها قالت الزوجة الملكية «موت أم ويا» لجلالة هذا الإله «آمون رع» رب الكرنك فلتَصِرْ أرواحك عظيمة في جلالتي ولتكن تصميماتك التي أنفذتها كاملة، وليكن اجتماعك معي جميلًا، ولتكن نطفتك الإلهية في كل أعضائي بوصفك أمير طيبة وبعد أن أتم الإله كل ما رغب فيه قال لها: إن أمنحوتب أمير سيكون اسم الابن الذي سيخرج من فرجك، وهي نفس الجملة التي خرجت من فيك وإنه سيحكم هذه المملكة الخيِّرة على الأرض قاطبة، وذلك لأن روحي هي له وكذلك تاجي، لأجل أن يحكم على الأرضين مثل «رع» أبديًّا ) راجع: Gayet, Le Temple de Luxer, dans les memoires de la Mission Francaise, t. XV Pl. Ixxi (Ixxiii); Rec. Trav. t. IX, P. 84-85).
وهذه الكلمات هي نفس كلام «نقطانب»، وإذا تأملنا معنى هذه النقوش رأينا أن الملك لأسباب نجهلها قد مَثُلَ على حين غفلة أمام الملكة وقد لبس لهذه المناسبة صورة «آمون» حتى يبقى أمينا لأسطورة الزواج الإلهي: فقد كان الزوج السماوي هو الذي أتم الزواج في صورة الزوج الأرضي، فلم يكن كما نرى تنكر «نقطانب» في صورة «زيوس-آمون» إلا تحقيقًا ماديًّا لما جاء في الشعائر الخاصة بالزواج الإلهي الفرعوني.
وعلى ذلك فإن القصة التي وردت نقلًا عن «كاليستنيس» ليست إلا تطورًا طبيعيًّا للفكرة القائلة إن «الإسكندر الأكبر ملك مصر يجب أن يكون ابن الإله الذي تناسل منه كل الملوك، فإذا اعترف بمبدأ هذا الأصل الشمس، فإن الخيال الشعبي قد حققه بالطرق التي كانت في متناوله، وإنه قد كرر للإسكندر و«أوليمبياس» ما جاء في اللاهوت المصري القديم عن الملوك الذين يجب أن يكون تدخل الإله الأعلى في إنجابهم مباشرًا لأجل أن يُمنحوا طهارة الدم الشمسي. »
وخلاصة القول أَنَّ «الإسكندر» قد أصبح إلهًا في مصر بطبيعة الحال وبدون مجهود، وذلك بالسير على حسب الأنظمة المصرية وبفضل المعتقدات الخاصة بالبلاد وحدها، ومجرد دخول الإسكندر وادي النيل والاعتراف به فيه فرعونًا لم يجعل في مقدوره أن يتخلص من ضرورة الحصول على أب إلهي، وأن يعلن أنه ابن «آمون» وابن «رع» وابن أولئك الآلهة كبارهم أو صغارهم ممن سيخاطبهم، ولم تخلصه صفته الهيلانية من هذا المصير؛ إذ الواقع أن مصر كان لها كثير من الحكام الأجانب وكان عليها أن تطبق نظريتها الخاصة بالملكية الشمسية تحقيقًا لتاريخها، ولذلك فإن الطرق التي استخدمها الفراعنة الذين من أصل مصري قد استعملها منذ زمن بعيد الفراعنة الذين هم من سلالة أجنبية، فهل كان الإسكندر يعلم كل ذلك عندما خاطب الوحي؟ والشيء الأكيد الذي نعلمه هو أن الإسكندر قد دخل أفريقيا مجرد إنسان من البشر بوصفه ابن «فليب»، وخرج منها بوصفه الإله الكامل ابن «آمون» راضيًا أو كارهًا، وهذه الموازنة التي أوردناها فيما سبق بين أقوال المؤرخين من الإغريق وبين ما جاء في النقوش المصرية القديمة دليل على أن «كاليستنيس» الإغريقي كانت له دراية بسير الأمور في مصر أو أنه قد قرأ كثيرًا عن مصر ومعتقداتها، ويرجع الفضل في ذلك إلى «مسبرو» في الموازنة، ولكن التعصب الفكري الأوروبي لا يقبل كثيرًا مما أوردناه هنا على الرغم من البراهين القاطعة التي تعززه (راجع: Maspero, Comment Alexander Devint Dieu En Egypte, Etudes De Mythol. & D’Archeol. Egypt. VI. P. 263 FF).
وقد كان الإسكندر الأكبر يرتاح كثيرًا عندما ينادى بابن «زيوس» (آمون) وإن لم يكن يجبر الناس على ندائه بهذا اللقب، غير أنه مع ذلك كان يغضب من المتشككين والهازئين الذين ينكرون عليه وحي «آمون».
هذا وقد ارتأى المؤرخ «بلوتارخ» غير هذا الزعم فذهب إلى أن هذا المظهر الديني من جانب الإسكندر لم يكن إلا تدبيرًا سياسيًّا يراد منه إدخال الرهبة في قلوب السكان غير الهيلانيين الذين كان بمعونتهم يمكن أن يوسع أطراف إمبراطوريته (راجع: Plutarch Alexander P 28) وكذلك يميل المؤرخ «أريان» إلى هذا الرأي بعينه (راجع: Arrian, VIII, 29, 6) ولكن تدل شواهد الأحوال على أن هذا الإيمان من جانب الإسكندر بأنه ابن الإله كان إيمانًا خالصًا مصدره المبالغة في غروره المفرط الذي سيطر على نفسه منذ البداية، ولا نزاع في أن ادِّعاءه بأنه ابن لإله كان يعد إهانة موجهة بصورة خاصة إلى ذكرى والده فليب، وقد كان هذا الموضوع الذي يتحدث عنه الإغريق دائمًا في أوقات غضبهم عن الإسكندر، ومن الأمور التي أحفظت نفوس قواده بدرجة عظيمة أمثال «بارمينو» و«فيلوتاس» Philotas و«كليتوس» Kleitus، وغيرهم من عظماء القواد وقاحة الإسكندر بإنكاره أبوَّةَ فليب، ووضْع نفسه فوق مستوى البشر، وعلى أية حال فإن الخوف من الإسكندر وإعجاب المقدونيين والإغريق به قد أجبرهم على قبول الواقع والرضا به.
والآن يتساءل المرء: لماذا اختار الإسكندر أن يسمي نفسه ابن الإله وبالذات ابن الإله «آمون»؟ والجواب عن ذلك يرجع إلى سببين رئيسين أساسهما أرض الكنانة نفسها ومكانتها في العالم القديم وتأثيرها على ما كان يحيط بها من أمم مختلفة من حيث الدين والعلوم وبسطة السلطان، ولأجل أن نفهم ذلك لا بد لنا من أن نرجع إلى الوراء بعيدًا قبل فتح الإسكندر لمصر لنرى ما كان لمصر من فضل ومكانة بين الأمم، وبخاصة بلاد الإغريق وما أخذته الأخيرة عن مصر منذ فجر التاريخ.
.....................................................
1- فيلسوف ومؤرخ إغريقي عاش في القرن الثاني الميلادي ولد في «نيكومديا» من أعمال «بثينيا» كتب تاريخ الإسكندر الأكبر وسماه «أناباس» Anabase وقد أصبح قنصلًا وقد كتب كذلك كتاب Les Entretiens et le manuel d’Epictete.
2- راجع: Strabo, L, VII, Frogm. 8, 1.
3- راجع: Cailiaud, Voyage à L’Oasis de Thebes, 1822–1860, Hoskins, A visit to the Great Oasis of the Libyan Desert; Brugsch, Reise nach der Grossen Oase, El Kharga, 1878.
4- راجع: The Bucheum, by Sir Robert Mond, Vol. I, P. 25.
5- راجع: Champollion, Monuments de l’Egypte et de la Nubie, Pl. CXLIV-CXL III; & t. I, P. 293-4; Rosellini, Monuments de […] Culto, Pl. LIII & p. 293–301; L. D. IV 60-61.
6- راجع: راجع مصر القديمة الجزء الثالث عشر.
 الاكثر قراءة في العصور القديمة في العالم
الاكثر قراءة في العصور القديمة في العالم
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)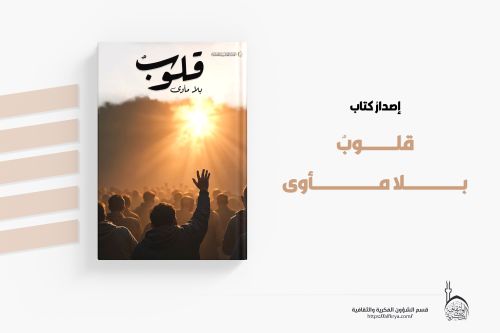 قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)


















